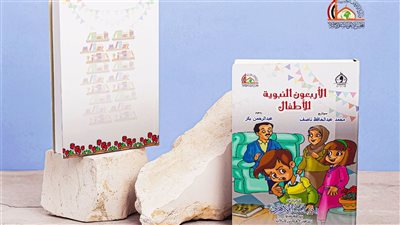احتفالات المولد النبوي..بين الفرح الشعبي والخلاف الفقهي

مع حلول الثاني عشر من ربيع الأول، تمتلئ الشوارع العربية بالأضواء والزينات وحلوى المولد، حيث يتجدد الفرح بذكرى مولد النبي محمد ﷺ.
ورغم رسوخ المناسبة في وجدان الشعوب الإسلامية، فإن الجدل الفقهي حول مشروعيتها ظل قائمًا عبر القرون، بين من يعدّها بدعة، ومن يراها مظهرًا مشروعًا للمحبة والتعظيم.
الخلفية التاريخية: من الفاطميين إلى العثمانيين
لم يُعرف الاحتفال بالمولد في صدر الإسلام، لكنه برز للمرة الأولى في العصر الفاطمي بمصر عام 969م، حين أطلق الخليفة المعز لدين الله مواكب
واحتفالات عامة للتقرب من المصريين. ومع تعاقب الدول، اتخذ المولد مسارًا متقلبًا:
- الأيوبيون: منعوا الاحتفال باعتباره دخيلًا.
- المماليك: أعادوا إحياءه وزادوا من مظاهره.
- العصر العثماني ومحمد علي باشا: عززت الطرق الصوفية تقليده، حتى صار جزءًا راسخًا من الحياة الشعبية والدينية في مصر وبلاد الشام.
هذا التاريخ المتدرج جعل المولد ليس مجرد طقس ديني، بل مناسبة ذات أبعاد سياسية وثقافية، تُستخدم أحيانًا لتأكيد الشرعية وتقوية الرابط مع الشعوب.
المذاهب الإسلامية: بين الرفض والقبول
- الصوفية: يرونه وسيلة للاتصال الروحي بالنبي ﷺ عبر الذكر والإنشاد.
- السلفية: اعتبروه بدعة لا أصل لها، استنادًا إلى رأي الشيخ ابن باز بأن الأعياد الشرعية محصورة في الفطر والأضحى.
- الأزهر الشريف: اتخذ موقفًا مرنًا، معتبرًا أن المولد تعبير عن المحبة، وأنه وإن لم يكن فرضًا، فهو "بدعة حسنة" على رأي ابن حجر العسقلاني والسيوطي.
- الشيعة: يحتفلون به في 17 ربيع الأول، ويرونه تكريمًا للنبي ﷺ وتأكيدًا لمكانته.
المولد في الوجدان الشعبي والفن
بعيدًا عن الجدل، ظل المولد مناسبة راسخة في الثقافة العربية.
ارتبط بالقصائد والمدائح النبوية، وأشهرها قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي "وُلد الهدى فالكائنات ضياء"، التي غنتها أم كلثوم وأصبحت نشيدًا خالدًا يرافق الاحتفالات حتى اليوم.
المولد النبوي ليس مجرد ذكرى دينية، بل محطة تاريخية وثقافية وروحانية تداخلت فيها السياسة مع الفقه، والشعبية مع الرسمية، لتؤكد أن محبة النبي ﷺ تعبر عن نفسها بأشكال شتى، بين مدائح وأناشيد، وزينة ومواكب، وخلافات لا تزال حاضرة منذ أكثر من ألف عام.