الدكتور علاء جانب الملقب بأمير الشعراء وكيل كلية اللغة العربية:
الإسلام لا يعرف «الوصاية»

الأزهر قلعة الحفاظ على اللغة والتراث
الشاعر الدكتور علاء جانب أستاذ الأدب والنقد وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف إحدى القامات الشعرية فى الساحة الأدبية، حيث حصل على لقب وجائزة أكبر مسابقة شعرية «أمير الشعراء» والتى تقام فى دولة الإمارات العربية الشقيقة، وفاز بالمركز الأول فى دورتها الخامسة عام 2013م ولقب أيضاً بلقب «سهم الجنوب».
ولد الشاعر الكبير عام 1973 بقرية عرابة أبودهب بمحافظة سوهاج. وتخرج فى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر عام 1996 وبدأ العمل بها أستاذا مشاركًا بقسم الأدب والنقد عام 1997م، وحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز 2002 عن رسالته «شعر الدكتور سعد ظلام.. دراسة تحليلية نقدية» وعين مدرسًا مساعدًا فى العام نفسه. ثم حصل على درجة العالمية «الدكتوراه» عام 2005 عن رسالته «الصورة الفنية فى قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير - تحليل ونقد وموازنة» بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات، وعين مدرسًا للأدب والنقد بالكلية ذاتها.
تجديد عقلية الداعية ضرورة.. بعيدًا عن تغيير ثوابت الدين

ترقى فى الكلية حتى صار وكيلا لها، كما يشغل منصب مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والثقافية. وصف النقاد شعره بقوة اللغة وفصاحة التعبير وعمق المعانى وصدق الوجدان وإبداع التصوير الفنى. له عدة دواوين شعرية وقصائد فصحى وزجل بالعامية المصرية، كما صدرت الأعمال الشعرية الكاملة له، وتناولت شعره بالدراسة عدد من الرسائل العلمية والأبحاث المنشورة فى الدوريات المحكمة.
حصل أستاذ الأدب والنقد على العديد من الجوائز والأوسمة منها درع وبردة وخاتم وجائزة أمير الشعراء فى أكبر مسابقة شعرية فى العصر الحديث من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث عام 2013، ودرع وتكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، ودرع جامعة نزوى بسلطنة عمان، كما حصل على المركز الأول فى جائزة «كتارا» عن قصيدته «كما يلتقى البحران» فى مديح السيدة خديجة رضى الله عنها، ودرع تكريم مؤسسة البابطين، ودرع وتكريم من العديد من النوادى والمراكز الأدبية فى الوطن العربى من السعودية والكويت وأبوظبى.
ناقش وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، وهو عضو مؤتمر أدباء مصر وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو ممثل مؤسسة الأزهر لدى وزارة التعليم العالى لإعداد استراتيجية الولاء والانتماء لطلائع مصر.
أثرى الشاعر والناقد الأدبى الكبير د. جانب المكتبة الأدبية والنقدية بالعديد من المؤلفات العلمية الرصينة التى ازدانت بها دروب العلم والثقافة والأدب.
«الوفد» التقت أمير الشعراء الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف وهذا نص الحوار.
< بداية.. نعود إلى مشاركتكم فى مسابقة «أمير الشعراء» كيف كانت؟
< كانت تجربة جيدة جيدًا من حيث التعرف على تجارب الشعراء الموجودين فى كل الأقطار العربية، من أجل التفوق عليهم أو منافستهم على الأقل، وكل ذلك يصب فى تجربتى الشعرية ويفيد القصيدة بشكل أو بآخر، ويفتح لنا روافد لم تكن موجودة من قبل المشاركة فى مسابقة أمير الشعراء، وهذا يوجد فى كل المسابقات الأدبية، لكن ميزة مسابقة «أمير الشعراء» عن غيرها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفتح أحضانها لكل المشاركين واستضافتهم استضافة كاملة، مما يعطى الفرصة لأكثر من 300 شاعر أن يلتقوا ويتنافسوا أو يطوروا من قصائدهم وينقلوا تجاربهم بعضهم البعض، مما يخلق نوعًا من الاحتكاك وسماع الشعر والتحفيز عليه وقديمًا قالوا «ما أعان على الشعر مثل سماعه» فأكثر شىء يفيد الشاعر هو أن يقرأ ويسمع لغيره، فلو ظل الشاعر منكفئًا على نفسه وحتى لو ظل مثقفًا عبر الكتب فستكون تجربته مثل تجربة العقاد، فتجربة «العقاد» الشعرية فكرية وذهنية أكثر منها عاطفية، لكن النزول إلى الناس والاحتكاك والمنتديات وغيره، فالقصيدة بدون جمهور ميتة، وكأنها لم تخرج أو كأنها لم تكتب غير الصالونات الثقافية المغلقة أو القراءة والحوار مع الكتب، كل هذا مفيد ولكن الأكثر فائدة للشاعر هو الاحتكاك بتجارب الشعراء الآخرين والاحتكاك أيضاً بالشارع ونبض الناس.
< لك تصريحان متناقضان.. أنك تكره الخوض فى السياسة، بالرغم من أن شعرك كله سياسى فما قولك؟
<< أكره الخوض فى السياسة بالمعنى العلمى والاصطلاحى لكلمة سياسة، لأننى لست خبيرًا سياسيا، وأنا ضد أن يتحدث أى فرد فى فن معين وهو ليس متخصصًا فيه، لكننى أقول أن شعرى متصل بالسياسة، بشكل أو بآخر، حتى لو كتبت عن الحب يظهر أثر السياسة على كتاباتى، لأن كل إنسان منا متماس أو محتك بالسياسة من وجهة نظر ما، وشعرى به العديد من القصائد السياسية منها «المؤامرة» و«رحلة التابوت» و«اليم»، لكن ما يجعلنى أكره السياسة أن الذى ينحاز لاتجاه معين يجد نفسه فى حرب مع الاتجاه المقابل، فالحديث فى السياسة يزيد الانشقاق والانقسام، ولذلك فالسياسة لها أهلها.

تعريب العلوم مفيد.. واتهام الأدب العربى بالجمود باطل
< ما تقييمك لتجربة الشعر الحر، خاصة أن هناك من يرى أنه محاولة من محاولات الهدم التى بدأت بالعامية؟
<< أولًا دمج أو الجمع ما بين الشعر العامى والشعر الحر خطأ، لأن هذا لون وهذا لون آخر، فالشعر العامى مكتوب باللهجة العامية، له موضوعاته وقصصه ومشكلاته، أما الشعر الحر فهو شعر الفصحى، وهو شعر موزون، وقد يكون فيه ما يسمى بالتقفية، فهو شعر موزون ومقفى، ولكنه تخلى فقط عن خاصية من خصائص القصيدة القديمة، وهى قصيدة وحدة البيت، فالقصيدة القديمة بها ما يسمى بوحدة البيت، بمعنى أن كل بيت وحدة منضبطة بعدد تفاعيل معينة وبقافية معينة، لا يصح أن يزيد عدد التفاعيل على العدد المطلوب ولا يقل إلا بالمقاييس والعلل المعروفة فى علم العروض والقافية، فالشعر الحر هو شعر فصيح يتناول ما يتناوله الشعر الفصيح من الموضوعات، أما الشعر العامى فهو حقل آخر من ألوان الإبداع، لأنه امتداد لما عرف قديمًا بفن الزجل، وفن الزجل له موضوعاته، فالشعر الفصيح دائمًا يختار الموضوعات الجميلة أو الموضوعات التى بها شيوع وعموم، بينما الشعر العامى دائمًا يميل إلى المحلية والإيغال فيها، فكلما كان محليًا أكثر زادت قيمته، وهناك شعراء كثر كتبوا شعر التفعيلة، فهم حلقة من حلقات سلسلة تاريخ الشعر العربى، لا يمكن لأحد أبدًا أن يلغى دورها وقيمتها، وهو مستمر إلى يومنا هذا، ويكتب عليه كبار الشعراء.
< للأزهر دور بارز فى الحفاظ على العربية والتصدى للتحديات التى تواجهها فماذا عن جهود كليتكم فى النهوض باللغة العربية وهل يقتصر واجب حماية لغة الضاد على جهة معينة؟
<< أول مادة فى الدستور تخص الأزهر، أنه هو المسئول عن تبليغ الدعوة الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية والتراث الإسلامى، فهاتان المهمتان هما وظيفة الأزهر فى الدستور فإذا قصر فيهما فسوف يعد مقصرًا، وإذا أداهما بالفعل فقد قام بدوره، ومهمته، ولكن السؤال هل الأزهر يقوم بهذا الدور، الإجابة نعم، فمن الطبيعى ألا يكون كل الناس علماء، والطبيعى أن يكون العلماء أقل فى العدد ممن حولهم، فهذه طبيعة اجتماعية وكونية، لأن العالم الواحد يصلح الله به أمة كاملة، فأساتذتنا الكبار أمثال الشيخ الشعراوى، والشيخ الباقورى، والشيخ الغزالى، والشيخ محمد زكى الدين إبراهيم، والإمام عبدالحليم محمود والدكتور أحمد الطيب، كل هؤلاء العلماء درسوا وتعلموا اللغة فى الأزهر، فالأزهر العظيم يحافظ على التراث الإسلامى واللغة العربية وكل الأزهريين الذين تعلموا فى الأزهر تعليمًا أزهريًا حقيقيًا تجدهم فى أى مجال من المجالات، فى علوم الشرع واللغة يتحدثون حديث القوى المثقف، العالم الواعى، فدور الأزهر لا ينكر فى مصر والعالم الإسلامى كله فى الحفاظ على اللغة العربية والتراث الإسلامى، ودور كلية اللغة العربية أيضاً، لأن هذه الكلية هى المنوط بها المحافظة على اللغة العربية حفاظًا حقيقيًا، فإذا كان القانون يقول أن الأزهر مسئول عن الحفاظ على العربية والتراث الإسلامى، فكلية اللغة العربية هى المسئولة عن تنفيذ ذلك مثلما كانت كليتا الشريعة والقانون وأصول الدين مسئولتين عما يخصهما من هذا التراث، فكلية اللغة العربية هى التى تمكن الباحث فى علوم الشرع وتمسكه مفاتيح التعامل مع النصوص الشرعية (قرآنًا وسنة وآراء الفقهاء) فكلية اللغة العربية هى قلعة الضاد، وهى الأداة الأزهرية التى تقوم على تنفيذ إجراء الحفاظ على اللغة العربية والتراث الإسلامى.

الميديا وثورة المعلومات أدت إلى اهتزاز منظومة القيم
< من الملاحظ أن اللغة العربية تعانى من عزلة شديدة، وهذا ينعكس جليًا فى التعاملات اليومية والتليفزيون والبرلمان.. فهل هناك استراتيجية محددة لرأب الصدع الذى قد يفضى لضياع العربية عن الأجيال القادمة؟
<< مبدئيًا أختلف مع مسألة العزلة الشديدة، أولًا قد تكون هناك عزلة لكن ليست شديدة، فإذا اتفقنا أن هناك عزلة، ولكن لا أرى هذه العزلة للغة العربية، فهى موجودة بقوة، موجودة فى الصحافة المكتوبة، وفى المواقع الإخبارية الوطنية، وموجودة فى خطابات رئيس الجمهورية وخطابات رؤساء المؤسسات الكبرى فى الدولة، مثل شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى، فليس هناك أحد لدينا إلا ويلقى خطابه كاملا باللغة العربية، إذن هذه العزلة لم تحدث، إنها موجودة فى الخطابات الخاصة بمجلس جامعة الدول العربية، فلا يتكلمون بالإنجليزية أو اللهجات المحلية، أيضاً المناقشات العلمية فى الكليات تتم باللغة العربية الفصحى، وكتابة الرسائل، إذن لاتوجد عزلة للغة العربية، لكن ما نتحدث عنه أنه لا توجد لغة عربية تنطق كما ينطقها العرب فى الجاهلية، فنحن لا نستخدم اللغة العربية المعربة، فى الشارع، لكن كلامنا العادى باللهجة العامية لكنها بالعربية غاية ما هناك أننا لا نستخدم الكلمات العربية معربة، أى بالتشكيل، لكن العامية تختلف من بلد إلى بلد حتى فى القرى والنجوع، فالعامية أيضاً بها مستويات، فهناك مستوى الحوارى الشعبية، التى كان حظها من التعليم قليلا، ثم هناك مستوى آخر من العامية تبعا لمستوى التعليم فى القرى، فهذه القرية قائمة على مناخ اجتماعى مستقر، فهناك عائلات ومعظمهم مستوى تعليمى عال، مثل أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعات، فلن يكون المستوى فى قرية مثل هذه القرية مثل مستوى حارة من الحوارى.
< قضية تعريب العلوم من القضايا المهمة لكن البعض يرى أن التعريب سيقطع الصلة بين اللغة العربية وبين التطور العلمى فى العالم.. فما ردك على هذا الطرح؟
<< طرح خاطئ جدًا، فالمعروف أن الخبراء فى تعليم اللغات يتحدثون عن أنه عندما نتعلم علمًا بلغته الأصلية لا نضيع وقتًا فى عملية الترجمة من علم لعلم، مهما كانت مهارة الإنسان فى تعلمه اللغة الأجنبية، يحتاج إلى انتقاله ما بين الكلام الذى يقرؤه ثم ترجمته إلى لغة أخرى، بغض النظر عن كونها اللغة العربية أو غيرها، الآن كلية الطب فى الفرقة الأولى مثلًا تشرح لهم المواد باللغة الإنجليزية كاملة فى المصطلحات، فكم يستغرق هؤلاء الطلاب من الوقت حتى يندمجوا مع الأستاذ ويدركوا المصطلحات الأجنبية وهل إذا تم التدريس لهم بلغته القومية من البداية، سوف يحتاجون إلى كل هذا الوقت، حتى يتعرفوا على هذا العلم والتعرف على مصطلحاته وخباياه وخصائصه أم سوف يكون هناك فرق بين تعلمهم بلغة يفهمونها ويدركون أسرارها وتعلمهم بلغة ما زالوا يتعرفون عليها، فمن يتعلم الطب وغيره من العلوم يتعلمها ويتعلم بالتوازى معها اللغة التى يتعلم بها الطب معًا، يتعلمون اللغة والطب معًا فهذا جهد مزدوج، أما إذا تعلموا بالعربية لغتهم الأصلية فسيكون الأمر يسيرًا.
< البعض يرى أن ترجمة الشعر تعد خيانة للنص الأصلى فما ردك على هذا الطرح؟
<< ليست خيانة، فكلمة خيانة خطأ وإلا كيف سنفهم ما يقوله هؤلاء الشعراء، فلابد من الترجمة، لكن المشكلة أنه لا ينقل النص بأسراره ومراميه، والخفايا والإشارات الموجودة فى النص فى لغته الأصلية، فهذا مستحيل، لكن سوف ينقل على الأقل 80% من النص، ويتبقى 20% يعتمد القارئ على نفسه فى تحصيلها، شريطة أن يتوفر للمترجم أولاً: أن يكون هو ذاته شاعرًا حتى يترجم الشعر، أو على الأقل يكون على علم بفن الشعر، فلا يكون مترجمًا للنص وفقط، فالمترجم الجيد هو من يترجم الحالة ذاتها، وليس الكلمات فقط، لأن هناك كلمات إذا ترجمت حرفيًا ستعطى إشارات بعيدة تمامًا عن المقصود عند الشاعر، فهناك أساتذة عظام مثل الدكتور محمد عنانى –رحمه الله- والشاعر الكبير الراحل رفعت سلام، فمثل هؤلاء هم الذين يستطيعون ترجمة التجربة الشعرية بأهدابها وأطرافها وإشاراتها وإيماءاتها، فالمترجم الحرفى يعتمد على ترجمة الكلام فقط.
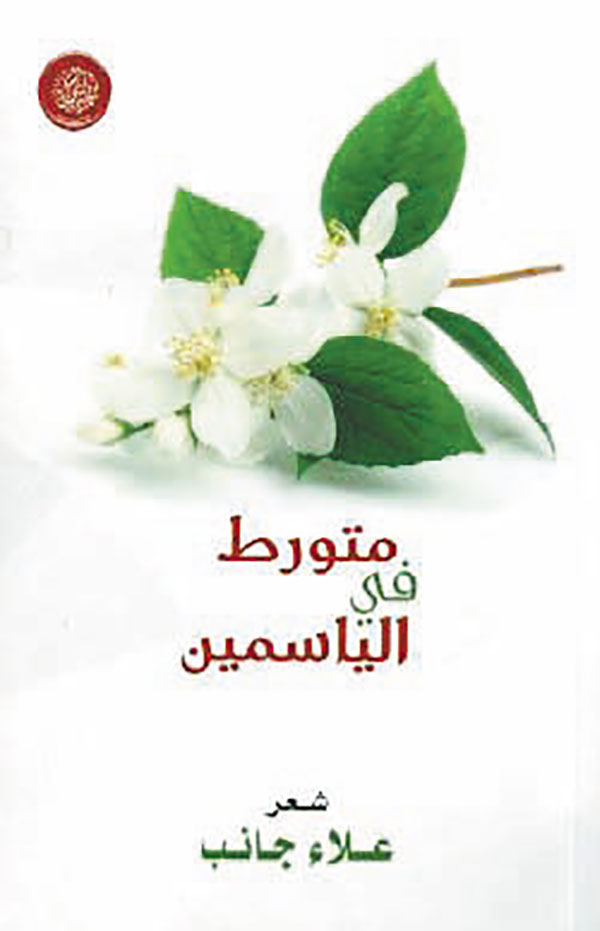
«الفرانكفونية» ظاهرة من ظواهر التطور اللهجى.. وترجمة الشعر ليست خيانة
< اللغة العربية جزء من الإسلام.. فكيف يمكن ازدهارها فى ظل ضعف المسلمين؟
<< اللغة العربية جزء من الإسلام هذا صحيح، وتعلمها أيضاً يدخل فى صلب الشريعة الإسلامية، لأنه لا توجد خطبة جمعة بدون لغة عربية والصلاة أيضاً، فهى بالفعل تدخل فى نسيج الإسلام، بالإضافة إلى ذلك الحج والتلبية، أضف إلى ذلك أن خميرة الإسلام مكتوبة باللغة العربية، فكل كتب الفقه والتفسير والحديث مكتوبة باللغة العربية، فاللغة العربية من الممكن أيضاً أن تزدهر فى ظل تدهور الشعوب العربية أو الأنظمة العربية مثلًا، ممكن جدًا، بدليل أن أكبر إمام من أئمة العربية هو سيبويه، فاللغة العربية من الممكن أن تضمحل فى نهضة العرب المادية، بدليل أنه فى الإمارات أو قطر من الدول العربية تجد أن التحدث بالعربية قليل جدًا فى الفنادق والمطارات، لكن اللغة العربية شأنها شأن أى لغة أخرى فى الدنيا من حيث الاضمحلال والضعف والتدهور ثم الضياع وانشقاقها إلى لغات أخرى، مثلما حدث مع اللغة اللاتينية وانشقت إلى الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية، فقد كانت هذه لهجات مشتقة من اللغة الأم، وهى اللاتينية، فاستقلت هذه اللهجات وأصبحت لغات مستقلة ومختلفة، فالآن الفارق كبير جدًا، بين اللغة الأمريكية واللغة الإنجليزية، فالكلمات ربما تكتب بحروف واحدة، لكن النطق مختلف تمامًا، فاللغة العربية كان من الممكن جدًا أن يكون مصيرها إلى هذا المآل، لكن الإسلام هو الذى حمى وحفظ اللغة العربية، فاللغة العربية لا يمكن أن تضمحل فى زهوة الإسلام والمسلمين مع العلم أنها يمكن أن تضمحل فى وجود تقدم عربى.
< نسمع كثيرًا عن «الفرانكو آراب» و«الفرانكفونية».. هل هناك تشابه بينهما وهل تعد هذه الظواهر من قبل الاستعمار الثقافي؟
<< هى ظاهرة من ظواهر التطور اللهجى واللغوى والكتابى، المتزامن مع الثورة المعلوماتية، فالميديا جعلتنا نعيش فى «لخبطة» واهتزازًا فى القيم، ولا أقصد القيم الأخلاقية تحديدًا، ولكن القيم بشكل عام، وكل ما كان له قيمة معينة لدينا وتقاليد، فالميديا ضربت وزلزلت هذا البناء، فالقصيدة التى كنت أكتبها منذ زمن مضى لتنشر فى صحيفة غير القصيدة التى أكتبها الآن لتنشر على «فيس بوك» فالشاعر واحد ولكن المتلقى مختلف، فبالتالى ليس لدى أنا والمتلقى الوقت الذى كان قديمًا، فأصبحت القصيدة من الممكن أن تكون قصيرة جدًا، ومن الممكن أن تكون كلماتها واضحة جدًا، لكنها تحتاج إلى تفخيم وإلى قاموس حتى نفهم معانى الكلمات، الرسائل الأدبية أصبحت قصيرة وسريعة، فوسائل التواصل الاجتماعى جعلتنا نزلزل كثيرًا من القيم التى كانت موجودة ونخلخلها لتحليلها، أما الفرانكوآراب، فهو عبارة عن حرف العين يشبه حرف (3) باللغة الإنجليزية، وحرف الحاء يشبه رقم (7) فى الإنجليزية، فيكون الأسهل فى الكتابة على الكيبورد باللغة الإنجليزية، فالشباب أصبحوا يستخدمون هذه الحروف عن طريق الأرقام بالإنجليزية التى تشبه هذه الحروف، فهو مزيج من الحروف والأرقام ونوع من أنواع الرموز المتفق عليها بين الشباب بعضهم البعض، وفكرة الكتابة بالفرانكوآراب تشبه فكرة الكتابة بـ«الأموشن» أى بالرموز والعلامات التى تدل على عواطف ومشاعرمعينة، فيستخدمون الرموز التى تشير إلى عاطفة أو إحساس من يكتب، فقد أصبح «الإيموشن» أيضاً لغة مساعدة يستخدمها الشباب بديلًا عن لغة الجسد أو لغة الملامح، وأعتقد أن هذه الظواهر لن تستمر كثيرًا، لأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، وهذا لا يعد من قبيل الاستعمار الثقافى، فليس هناك شكل من أشكال حياتنا يوحى بالاستعمار، ولكنى أميل إلى تسميتها «تلاقح ثقافى»، فنحن غير مستعمرين حتى يفرض أحد علينا شيئًا، وإنما نحن نرى ونستقبل بإرادتنا، لكن الاستعمار الثقافى هو الذى يخلخل القيم والانتماء والهوية ويشكك فى وطنك، ودينك ووطنيتك، وفى من يعيشون معك فى نفس بلدك، لأن الاستعمار فى الحقيقة هو استخراب وليس استعمارًا، فليس من همه أن يجعلنا أهل عمران، وإنما هو من شأنه أن يجعل نفسه أهل عمارة بواسطتنا، ويأخذ خيراتنا، وهذه هى فلسفة الاستعمار، فهو فى الحقيقة اسم جميل لإجراء قبيح وهو استغلال خيرات بلاد وشعوب واللعب فى مقدراتهم بكلمة جميلة تسمى استعمار، لكن الثابت أن الإنجليز والفرنسيين لم يستعمروا بل خربوا أكثر مما عمروا.
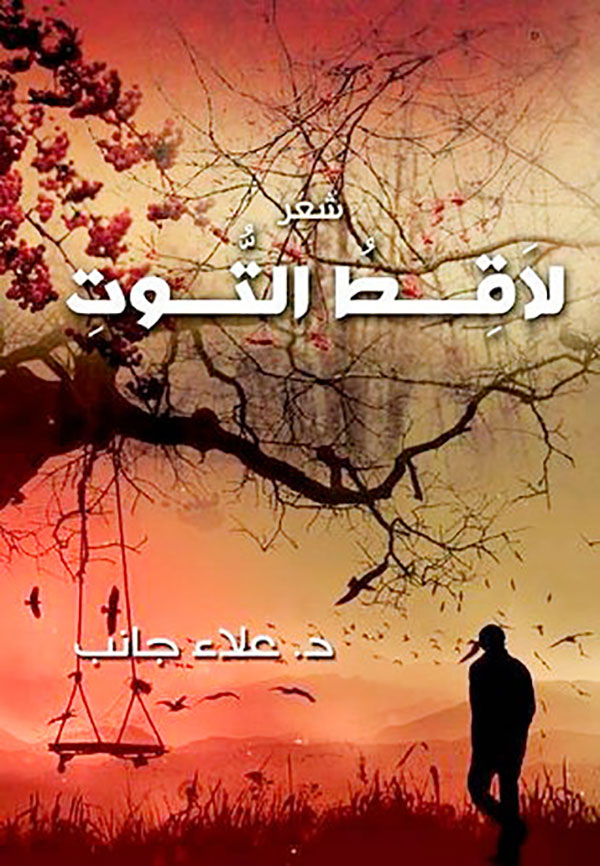
< قديمًا طالب أحد نواب البرلمان بمنع تدريس اللغات الأجنبية فهل ترى أن تدريسها سبب تدهور العربية، وهل وجود هذه المدارس يؤثر بالسلب على لغة الضاد؟
<< وجود لغات أخرى مع اللغة العربية لا يؤثر بالسلب على اللغة طالما أن أهل هذه اللغة متمسكون بهويتهم ويعرفون قيمة لغتهم، لا يمكن أن يتأثروا، بالعكس، فحركة الترجمة الواسعة التى تمت أيام المنصور وهارون الرشيد فى بغداد، هذه الحركة الواسعة للترجمة، وسعت رقعة اللغة العربية إلى ما نتخيله، وأدخلت فيها آلاف المفردات وآلاف الأفكار الجديدة، بما يسمى بالتعريب، فأصبح هناك ما يسمى بالمعرب والدخيل، بالإضافة إلى دخول أفكار لم تكن موجودة عند العرب، مثل علم المنطق، فلا يمكن أبدًا أن تكون حركات الترجمة وحركات التلاقح اللغوى سببًا من أسباب ضعف اللغة، بالعكس فمن المعروف أن اللغة كلما احتكت بغيرها من اللغات زادت رقعتها وزادت ضياء على ضياء، لكنها تكون خطرًا، عندما يسمح أهل هذه اللغة لأنفسهم بالذوبان فى ثقافة الآخر، ويلغون شخصيتهم تمامًا، لكن ما دام نحن متمسكون بلغتنا الأصلية، فليس هناك خطر على اللغة، أما مطالب أحد النواب بتدريس اللغة الأجنبية فأعتقد أن هذا خطأ كبير جدًا، ولكننى مع أن يكون تدريس اللغات الأجنبية فى سن متأخرة، فلا ندرس للطفل لغة غريبة تزاحم لغته الأصلية وهو فى الحضانة ومرحلة التعليم الأساسى فى الابتدائية، ولكن من الممكن تدريسها فى المرحلة الإعدادية مثلما كان يحدث فى الماضى، أو حتى على الأقل فى المرحلة الثانوية، حتى يكون الطفل قد رسخ لغته القومية، فهو لغة الأمة كلها وليس وطنًا بعينه، ومصر أكبر دولة عربية بها حفاظ على اللغة العربية، بفضل الله ثم بفضل الأزهر الشريف، ولابد من تشجيع اللغات غير العربية ولكن بعد أن يكون الطفل رسخ فى نفسه ووجدانه لغته القومية وأصبح يستطيع أن يفهم بها وأن يتعلل بها ويستطيع أن يفهم معنى الإعراب والبناء، فإذا زاحمت عقله بلغة أخرى فى سن مبكرة يخرج مشوشًا، لا يحسن لغته الأصلية ولا اللغة الأجنبية التى يتعلمها، وهذا كلام خبراء تعليم اللغة.
< قديمًا.. قال «ابن خلدون» إن المغلوب مولع دائمًا بتقليد الغالب فى سائر أحواله فهل هذه المقولة تنطبق على تقليدنا الأعمى للغرب والسعى لتعلم لغته وترك لغتنا؟
<< هل نحن كلنا نقلد تقليدًا أعمى أم أن هناك تقليدًا على العكس من ذلك، قطعًا هنا تقليد مبصر، والإنسان أول ما تعلم دفن أخيه تعلم ذلك من طائر أعجم لا ينطبق ولا يعقل اسمه الغراب، فهذا تقليد، فليس كل تقليد ضار وليس كل تقليد أعمى، فالتقليد الأعمى هو تقليد مجتمعات غربية أو شرقية فى أمور لا تتفق مع الأعراف والتقاليد والعادات وثقافتنا.
< يقول الدكتور الراحل حسن حنفى: تستطيع الذات العربية أن تستعيد هويتها ووحدتها وتقضى على اغترابها بالتوحيد بين «الهوية واللغة» ما رأيك فى هذه المقولة؟
<< مسألة الفصل بين الهوية واللغة غير جائزة، فاللغة هى بطاقة الهوية، وهى وجه الهوية، فمن غير لغة كيف نفهم الهوية، فالألمان إلى الآن لا يقبلون مناقشة بحث علمى ولا نشر مقال فى مجلاتهم إلا بلغتهم، اعتزازًا بهويتهم، ولذلك أتفق تمامًا مع رأى الدكتور حسن حنفى -رحمه الله- فاللغة والهوية وجهان لعملة واحدة، لأن اللغة هى التى تخرج الهوية، والهوية من غير لغة كأنها موجودة بالقوة وليست موجودة بالفعل.
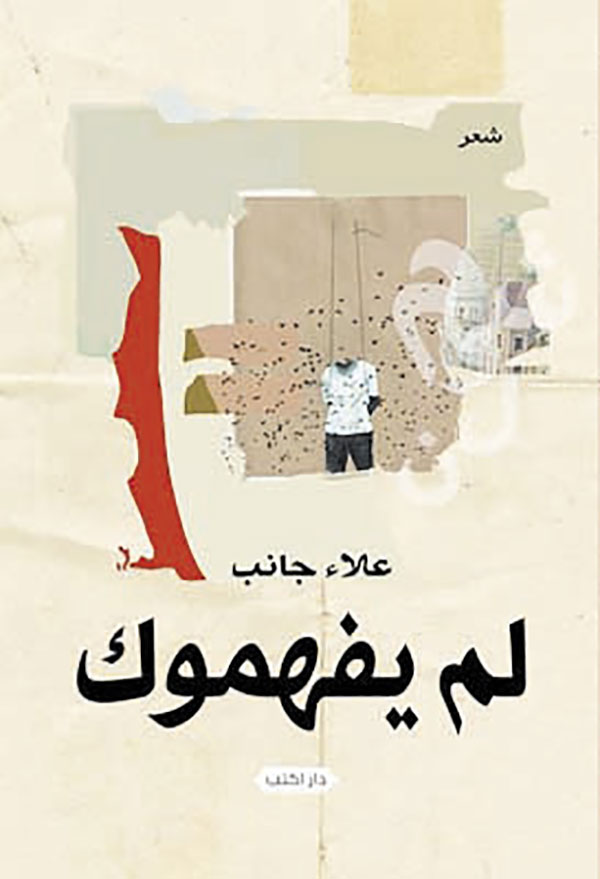
< بماذا ترد على من يتهم الأدب العربى بأنه جامد متحجر؟
<< أين هذا الجمود والتحجر فى الأدب العربى، هل هو فى الكلام أم فى رقة المشاعر التى يحويها الكلام أم فى المضامين العقلية والفلسفية والوجدانية، فإذا تحدثنا عن الجمود بمعنى القوة فهذا غير صحيح، لأن الأدب العربى فى غاية الرقة، فلو قصدنا بالجمود أنه صلب ومتحجر ولا يعبر عن المشاعر الإنسانية فهذا خطأ، فلم يعبر أحد عن الحب مثل العرب، بشعرهم ونثرهم، ولم يعبر أحد عن الوفاء أو القيم الإنسانية فى كل أشكالها مثل العرب، بكوا على المنازل المهدومة والأطلال وبكوا على فراق الحبيبة وبكوا وفاء على الموتى الذين رثوهم بالقصائد، وأعجبوا فمدحوا بأرقى أوصاف المديح، وسخطوا فوصفوا بأكثر الأشياء سخطًا فى قصائد الهجاء والمناظرات، ففى كل المعانى الوجدانية كان الشعر العربى معروفًا، وإذا أردنا بالجمود الوقوف عند شكل معين أو طريقة معينة فى الأداء، فهذا خطأ أيضاً، لأننا لو تحدثنا عن جنس واحد من أجناس الأدب العربى وهو الشعر، وأخذناه من بداياته إلى الآن فسنرى أكثر من شكل أخذته القصيدة العربية وتحورت فيه بوصفها شعرًا، فسنجد أشكالا كثيرة مثل «القريض» وهو القصيدة المعروفة، ومن حيث الطول والقصر فهناك القطعة والنتفة والبيت اليتيم و«المزدوج»، أما من حيث النوعية فهناك القصيدة والموشحة والمخمس والمربع والسلسلة، ثم الزجل، والذى يأخذ مجموعة أشكال أيضاً، فالعامى والفصيح لهما أشكال كثيرة، إذن فالشعر العربى لم يقف عند شكل واحد، وعندما بدأنا فى العصر الحديث أصبحت لدينا قصيدة الشعر الحر، وبعض النقاد يعترف بها وبعضهم لا يعترف بها، لكن هى موجودة وكتبها شعراء كبار يستطيعون كتابة القصيدة التقليدية مثل أمل دنقل، ونزار قبانى، ومن شعرائنا الحاليين من يكتب التفعيلة أو الحر كما يكتب القصيدة القديمة، فالشعر لم يتوقف عند شكل معين ولا كان جامدًا ولا كانت موضوعاته كما هى، بالعكس موضوعات مختلفة، فشعر أحمد شوقى يختلف مع شعر الفرزدق بالرغم من وحدة الوزن والقافية، حتى فى المديح والهجاء، حتى أن شوقى عندما عارض «البوصيرى» كانت تظهر عليه الروح الحديثة، إذن اتهام الأدب العربى بالجمود اتهام باطل ولا يؤيده الواقع ولا كمية الدراسات الكبرى والواسعة حول دراسة الأدب العربى فى تطوراته وتحديثاته.
< طالب البعض بإبعاد التراث الإسلامى لأنه لا يتناسب مع مقتضيات العصر، فيما رفض البعض الآخر التفريط فيه فإلى أى الفريقين تميل؟
<< لا أميل إلى هذا أو ذاك، فالقدماء اجتهدوا بما يلائم معطيات عصرهم، فى كل مرة، وهذا التراث ينطبق على اللغوى والتاريخى والفقهى والعقدى، فى كل أشكال العلم والثقافة الإسلامية، فلدينا تراث كبير جدًا، فليس من المعقول أن نعيش بمعطيات عصر الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام مالك أو حتى بمعطيات عصر النبوة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له معطياته فى أيامه، فمثلا الأحكام المتعلقة بالسفر فى مسألة الإفطار وقصر الصلاة، هناك اجتهادات للعلماء تقول أن زمان كانت الدابة تأخذ فترة طويلة، أما الآن فالسفر أصبح سهلا،وهناك من يقولون أن السفر هو السفر، فكل نوع من أنواع السفر له عذابه ومشاقه، فهناك أناس يأخذون بالرخصة وآخرون يرفضون، إذن لا التمسك بكل ما فى التراث مفيد للتراث، لأن التراث نفسه لا يريد منا ذلك، فأساتذتنا وأسلافنا وآباؤنا لا يريدون منا أن نتمسك حرفيًا بما يقولون ولا أن نرمى التراث بالمرة، لأن هذا جنون، وقلة عقل وضمير، لأن هؤلاء الذين اشتغلوا على أنفسهم فى العلوم ليحفظوا لنا هويتنا وما ينفعنا فى الدنيا والآخرة، فلا يصح أن نلقى بكل ما قدموه فى البحر، فالرسول يقول: «ندَّر الله وجه عبد سمع منى مقالة ثم بلغها كما سمعها فربما مبلغٍ أوعى من سامعٍ».
< كيف يمكن إزالة اتهام الآخر للخطاب الإسلامى بأنه دينى بحت ولا يواكب العصر والمعطيات الاجتماعية الجديدة، وكيف تنظر إلى قضية تجديد الخطاب الدينى، وهل المؤسسات الدينية ما زالت متعثرة فى هذه القضية؟
<< هناك مشكلة كبيرة جدًا يقع فيها البعض عندما يشبهون الدين الإسلامى بغيره من الأديان فى بعض المسائل، أولا الخطاب الإسلامى ليس فيه وصاية من أحد على أحد، حتى دور الدعاة والشيوخ والعلماء ليس دورًا وصائيًا، أو ليس دورًا فيه «باباوية» وإنما هو دور إرشادى وتوعوى وتعلم وتعليم وليس دور سيطرة ووصاية، فليس هناك فى الإسلام من يمسك «صك» فى يده يستطيع أن يبيع به الجنة لأحد، ولكن غاية ما نستطيعه أن هناك مبادئ معينة جاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، ولذلك فإن بعض الناس يخلطون بين الإسلام وغيره من الديانات فى هذا التصور، فما المقصود هل الخطاب العلمى أم خطاب الدعاة إلى الإسلام والمبلغين لهذا الدين سواء داخل الوطن أو خارجه، فأعتقد أن أى دين فى الدنيا أتباعه أو الدعاة إليه يحاولون إفهام الناس أسآسيات هذا الدين، فالخطاب الدينى موضوعه هو الدين نصوصًا أو إجراءات أو ما إلى ذلك، فلابد أن يكون الخطاب إسلاميا، أما إذا كان الحديث عن الأداة التى أوصل بها المعلومة عن الدين الإسلامى بشكل صحيح فهذا هو الذى يجب تطويره، بمعنى الطريقة التقليدية التى كان يتعامل بها فى الإفتاء مثلا، المفتون العظماء من المفتين القدماء، هل أصبحت اليوم هى الطريقة الناجعة فى الإفتاء، فنحن اليوم فى حاجة إلى فتاوى إلكترونية فى الفيس بوك وتويتر والانستجرام، فهناك من يحتاجون إلى الفتاوى التى تواكب مستجدات العصر ومعطياته، فتجديد الخطاب الدينى يجب أن يكون تجديدًا فى الأدوات وشكل وعقلية الداعية، فنحن لن نغير فى أسآسيات وثوابت الدين ولكن التغيير فى أدوات الداعية التى يستخدمها، بعيدًا عن الابتداع فى الدين، أما الابتداع فى الحياة فنحن مأمورون به، فنحن مأمورون بتطوير حياتنا، فتجديد الخطاب الدينى أمر مطلوب ليس فى عصرنا فقط، فلو نظرنا إلى أئمتنا وفقهائنا على اختلاف أزمنتهم سنجد أن كل واحد فيهم كان مجددًا فى زمنه، مثل الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعى وأبو حنيفة، وكل هؤلاء مجددون فى الخطاب الدينى فى أزمانهم بشكل أو بآخر، والصحابة مجددون فى الخطاب الدينى وليسوا مجددين فى جوهر الدين، فالتجديد فى الخطاب الدينى أمر مطلوب فى كل العصور.
< أخيرا.. ما آخر أعمالكم الشعرية؟
<< لى ستة دواوين شعرية مطبوعة منها «وأنا وحدى» و«ولد ويكتب النجوم» و«لاقط التوت» و«متورط فى الياسمين» و«السكوت» و«لم يفهموك» و«المغنى»، ومجموعة فى مجلد واحد «الأعمال الكاملة حتى 2020» ولدىّ كتاب جديد قريبًا، وعندى ديوان بالشعر العامى تحت الطبع، ولدى ثلاثة دواوين فصحى تصدر قريبًا.

