ورغم أنني أتفنن كل عامٍ في اختيار أشكال الفوانيس وألوانها،وتعدد ما تحمله من أغنيات تراثية تعلن قدوم شهر رمضان إلا أني لا أرى شغفاً في عيون أحفادي كشغفي-وأنا دون الخامسة في طفولتي السكندرية-حينما اشترى لي أبي ذلك الفانوس ذا الشكل التقليدي؛كنت والرفاق من صغار الشارع نتعاون في تثبيت تلك الشمعة المشتعلة في منتصفه حفاظاً عليها من الانطفاء،وعلى أصابعنا من قطرات الشمع الساخنة جدا،والتي ما تلبث أن تتجمد فور تساقطها على يد من يحاوطها لئلَّا تعابثها هبَّةُ هواءٍ؛كيما نسير منشدين تلك الكلمات"حالو ياحالو..رمضان كريم ياحالو" وكثيراً مااتهمتُ مهارتي في انتقاء تلك الفوانيس ذات الإضاءة بكل الألوان، والتي تختلف تصميماتها وتتفق في أصلها الصيني، ورغم براعة صناعتها إلا أني أراها شديدة الفشل في إثارة شغف أحفادي؛إذْ لا يكترثون كثيراً، ويعاودون مرةً أخرى الغرق في أجهزتهم اللوحية من جديد
أظن أنني أرى الأمر بعين التهويل كعادة الأجداد الذين يقيسون الكثير من تصرفات أحفادهم بمقاييسَ أزمنةٍ فائتةٍ؛لكنني أعترف أن هناك من التغييرات ما لا يمكننا القدرة على مجاراتها أو التوافق معها،ذلك العجز هو ما يدفعنا إلى الفرار بشغفٍ إلى الذاكرة، لاهثين في استعادة أدق التفاصيل دونما كلل..!! وهل هناك من أحدٍ أمكنه الصمودُ إذا ما جرفه تيارُ الحنين إلى الطفولة كلما عاود القدومَ شهرُ رمضانَ بلياليه العامرة وذكرياته؟!بل لعلنا لا نكون مُغالين إذا قلنا إن شغفنا وحنيننا إلى الطفولة ليس مقتصرا على مناسبة بعينها كشهر رمضان مثلاً،وإن كان يمثِّل باباً واسعاً لما فيه من سلوكيات اجتماعية وصلاتٍ إنسانية استقرت في الهامش بعدما رأيناها تحتل عمق الصورة..!! ما الذي جعل الشاعر الرقيق "إبراهيم ناجي"يهتف في قصيدة"الوداع"بهذين البيتين النازفيْن:
(كلُّ شئٍ صار مرًّا في فمي/بعدما أصبحتُ بالدنيا عليما)(آه من يأخذُ عمري كلَّه/ويعيدُ الطفلَ والجهلَ القديما)
لقد وضع إصبعه مُحدِّداً مكمن مرارته وباعث ألمه؛وهو العجز عن مجاراة ما تحمله الدنيا من تقلباتٍ، وفقدان مهارة التكيف مع واقعه الذي لا يتحمله،
وأظنني أرى أننا سنكون آخر الأجيال الذين تتصل شرايينُهم بشرايين أجدادهم الأوائل الذين حملوا ذكرياتهم في قلوبهم أينما حلُّوا وحيثما ارتحلوا؛فوقفوا بالأطلال وذكروا الديار؛أجل...لم يكن وقوفُهم بهذه الآثار وقوفَ جماداتٍ فاقدةِ الشعور والفكر؛بل كان ذهاباً اختيارياً إلى مملكة الألم بأقدامهم،ووقوفاً طوعياً لاستنقاذ أرواحِهم من فخاخ النسيان، وقلوبِهم من الجمود، وأحساسيهم من البرود، وكلما جدَّدنا الحديث عن ذكرياتنا بللتْها دموعٌ لا تُرى أسفاً على أيامٍ جميلةٍ بلا عودة فرَّتْ،وذكرياتٍ لم تزل دافئةً لكنها في الزوايا قد اختبأتْ، وأحبَّةٍ غابوا عن الأعين لكنّ آثارَهم لبطش الزمن ما امتثلتْ..!!
أجلْ..ترددتُ طويلاً ما بين شغف الحنين وشجن الحنين؛إذْ تظل نوافذُ الحنين مُشْرَعةً دوماً لاجتذاب الشجن ليأتي الختام درويشياً مُفعَما بمنمنماته الإنسانية التي لانملك في حضْرتها سوى الصمت المُبلَّلِ بالشجن..!! فإلى قصيدة"إلى أمِّي" والكبير
"محمود درويش":
(أحنُّ إلى خبز أمي/ وقهوة أُمي/ولمسة أُمي.!!/ وتكبر فيَّ الطفولةُ يوماً على صدر يومِ/ وأعشَقُ عمرِي لأني إذا مُتُّ أخجل من دمع أُمي!!/ خذيني، إذا عدتُ يوماً وشاحاً لهُدْبِكْ/وغطّي عظامي بعشبٍ تعمَّد من طهر كعبكْ/ وشُدّي وثاقي.. بخصلة شَعْرٍ.. بخيطٍ يلوَّح في ذيل ثوبكْ/ عساني أصيرُ إلهاً..إلهاً أصيرْ..إذا ما لمستُ قرارة قلبكْ!!/ ضعيني..إذا ما رجعتُ وقوداً بتنور ناركْ/ وحبلَ غسيلٍ على سطح داركْ/ لأني فقدتُ الوقوف بدون صلاة نهاركْ/ هرمتُ، فردّي نجوم الطفولة حتى أُشاركْ/ صغار العصافير درب الرجوع..لعُشِّ انتظارِكْ!)


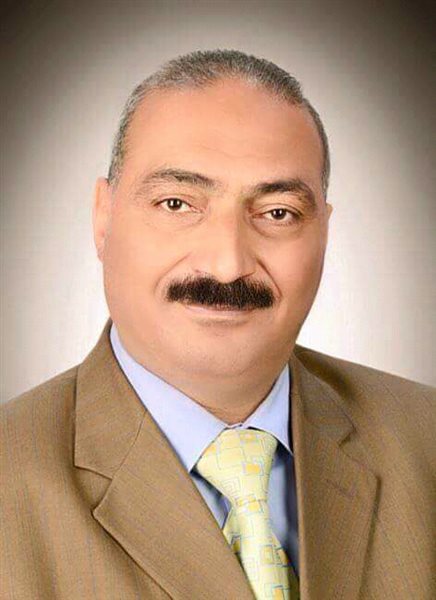
 تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض