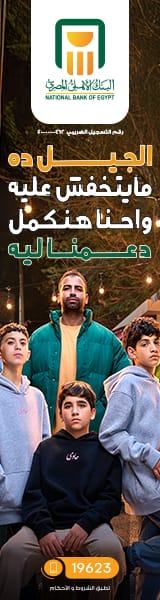كبسولة فلسفية
أما النقاشات النقدية اللاحقة، ولا سيما مع الفيلسوف الأمريكي جون ديوي، فقد أعادت صياغة البراجماتية في أفق أوسع. فلم تعد مجرد أداة لاختبار صلاحية المعرفة، بل غدت مشروعًا لفهم كيفية نشأة المعرفة وتطورها في سياق حاجات الإنسان وتجربته المتجددة. ومن هنا تحولت البراجماتية من كونها "مبدأً منهجيًا" محدودًا إلى فلسفة متكاملة ذات تاريخ ومضمون، تسعى إلى كسر الحدود التقليدية بين الفكر والعمل، وبين النظرية والتطبيق، في محاولة لربط الفلسفة مباشرةً بالحياة اليومية.
وفي هذا السياق، جاءت مقالات البروفيسور جيمس مارك بالدون – فيلسوف وعالم نفسي أمريكي – حول "حدود البراجماتية"، حيث انطلق من افتراضين أساسيين: أولهما أنّ جون ديوي يُعَدّ براجماتيًا خالصًا، وثانيهما أنّ البراجماتية تفترض وجود جانب ثابت من التجربة يُبنى عليه نسق فلسفي يلبي الحاجات العملية. غير أنّ الواقع يكشف عن رؤية أكثر تعقيدًا لدى ديوي؛ إذ رفض أن تُعامل "الحاجات" كمعطيات جامدة، مؤكدًا أنها بدورها تخضع للتفسير والفهم داخل الدورة الحية للتجربة الإنسانية.
هذا النقاش يكشف مأزقًا أوسع: هل يمكن منح البراجماتية تعريفًا جامدًا أو تحويلها إلى "مدرسة فلسفية" قائمة بذاتها؟ المدافعون عن هذا التيار يرفضون ذلك، مؤكدين أن قوته تكمن في ديناميكيته وقدرته على كسر القوالب المنطقية الجامدة، حتى وإن عرّضه ذلك لاتهامات بالضبابية أو الغموض.
ومن هنا، جاء الاجتماع الأخير للجمعية الفلسفية الأمريكية في برنستون ليجسّد هذا المأزق عمليًا؛ إذ بدا واضحًا أن مصطلح "البراجماتية " صار يُستعمل الآن بمعنى أوسع يشمل اتجاهات متعددة: من "المدرسة الشيكاغوية" ذات الفهم الوظيفي للتجربة، إلى "النزعة الإنسانية" عند شيلر، مرورًا بما يُعرف بالواقعية الديناميكية. وفي هذا اللقاء قدّم جيمس إدوين كريتون – فيلسوف أمريكي – ورقة بعنوان "الغرض كفئة منطقية"، انتقد فيها البراجماتية لأنها لم تُنصف "العنصر الفكري" في التجربة ولم تمنح الوعي الذاتي مكانته الكافية، معتبرًا أنّ هذا التيار، في جوهره، فردي النزعة.
وفي السياق نفسه، لم يكن كريتون وحده من وجّه سهام النقد، بل شاركه الرئيس الفيلسوف جوزياه رويس – فيلسوف أمريكي – ببحثه حول "الأبدي والعملي". فقد رأى أنّ معيار البراجماتية للحقيقة يفتقر إلى مرجعية موضوعية أو اجتماعية، وأنّ أحكامها الفردية لحظية زائلة، لأنها لا تستند إلى وعي كوني أو "معيار أبدي". غير أنه، في المقابل، لم يُنكر أهميتها، بل أقرّ بقيمتها كأداة عملية لمواجهة المواقف الجزئية في الحياة اليومية، لتبقى البراجماتية في نظره تيارًا نافذًا، وإن كان غير مكتمل الأفق.
أما المناقشات اللاحقة، خاصة تلك التي شارك فيها ممثلو جامعة شيكاغو، فقد شددت على أنّ كثيرًا من النقد وُجِّه إلى البراجماتية من زاوية ضيقة، وكأنها تفصل بين الفكر والعمل. بينما الحقيقة أنّ هذا التيار يسعى إلى فهمهما كمراحل متصلة داخل عملية واحدة لا تنفصم. ومن هذا المنطلق، رأى أنصار البراجماتية أنّ المطالبة بمرجعية مطلقة للحقيقة ليست ضرورية، إذ يمكن إعادة صياغة فكرة "المطلق" ذاتها بلغة اجتماعية براجماتية، تظل منفتحة على التجربة ومتغيّراتها.
وهكذا، يتضح أنّ البراجماتية لم تكن يومًا مجرد نزعة عابرة أو حيلة منهجية مؤقتة، بل محاولة جريئة لإعادة تعريف علاقة الإنسان بالحقيقة والحياة معًا. إنها فلسفة تُصرّ على أن المعرفة ليست كيانًا جامدًا يُحتفظ به في المتاحف الفكرية، بل كائن حيّ يتنفس من حاجاتنا ويتشكل في مسار تجربتنا. ولعلّ قوتها الكبرى تكمن في هذا التوتر الخلّاق بين المرونة والبحث عن المعنى، بين الشك الدائم والإيمان بجدوى العمل. ومن هنا، فإن البراجماتية لا تنغلق في مدرسة ولا تذوب في نظرية، بل تبقى نداءً مفتوحًا: أن نفكر لنحيا، وأن نحيا لنفكر، في دائرة لا تنتهي من التساؤل والإبداع.
[email protected]