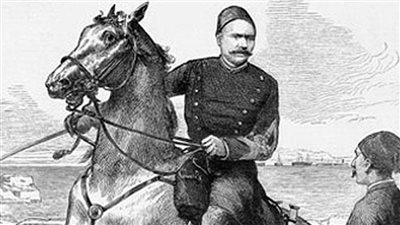حدث في مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من رمضان .. رحيل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي

حدث في مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من رمضان ، مقتل أبي الطيب المتنبي سنة 354، عن عمر 51 عاماً، أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجُعفي الكِندي الكوفي، أحد أعلام الشعر العربي، له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة.
ولد أبو الطيب سنة 303 بالكوفة في محلة تسمى كِندة وإليها نسبته، والجعفي نسبة لقبيلة همدانية من اليمن أبوها جُعفيُّ بن سعد العشيرة المَذحجي، وكان والد أبي الطيب الحسين يقال له عَبدان ويعمل سقّاءً على بعير له، وتعلم أبو الطيب الكتابة والقراءة، وكان منذ نعومة أظفاره يحب العلم والأدب، وأكثر من التردد على محلات الورّاقين من بائعي الكتب وناسخيها، يقرأ ما عندهم من الكتب، ويحفظ كثيراً منها، فاستفاد من ذلك استفادة كبيرة، وصار آية في اللغة العربية ومرجعاً في مفرداتها، كما سيمر معنا في موضعه، ومما كان يحفظه كتاب الجمهرة في اللغة لابن دريد محمد بن الحسين الأزدي، المتوفى سنة 321.
وكان أبو الطيب يتمتع بذاكرة قوية مكنته من الحفظ والاستيعاب لما يقرأ، وحدّث أحد الوراقين الذين كان يجلس إليهم، قال: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى! قيل له: كيف؟ قال: كان اليوم عندي، وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعي، نحو ثلاثين ورقة، ليبيعه، فأخذ الفتى ينظر إليه طويلاً، فقال له الرجل: يا هذا، أريد بيعه، وقد قطعتني عن ذلك، وإن كنت تريد حفظه، فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر. فقال له: فإن كنتُ قد حفظتُه في هذه المدة، ما لي عليك؟ قال: أهب لك الكتاب. فأخذ المتنبي الدفتر من يده، فأقبل يتلوه عليه إلى آخره، ثم استلمه، فجعله في كمه، فقام صاحبه وتعلق به، وطالبه بالثمن، فقال: ما إلى ذلك سبيل قد وهبتَه لي. ومنعه الوراقون منه، وقالوا له: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام. فتركه عليه.
ثم خرج أبو الطيب إلى بادية السماوة بين الكوفة والشام، وصحب قبيلة كلب يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس، فجاء بعد سنين بدوياً قحاً، وفي هذه المرحلة من حياته ادعى أبو الطيب النبوة، وكان لما خرج إلى كلب ادعى أنه علوي حسني، ثم ادعى النبوة والوحي، وصار يذكر لأتباعه سوراً مما أوحي إليه، فتبعه كثيرون من أهل البادية، وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ أمير حمص ونائب الإخشيد فيها وأسره وحبسه حبساً طويلاً فاعتل حتى أشفى على الموت، ثم شفع له بعضهم واستتابه وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه في النسب والنبوة، ورجوعه إلى الإسلام وأنه تائب من ذلك، ولا يعاود مثله، فأطلقه.
وكانت تلك صفحة من حياة المتنبي يود أن يطويها فلا تُذكر، وكان إذا سئل عنها غالط فيها، قال القاضي المحسن بن علي التنوخي، المولود سنة 327، صاحب نشوار المحاضرة: سألته بالأهواز في سنة 354 عند اجتيازه بها إلى فارس في حديث طويل جرى بيننا عن معنى المتنبي لأني أردت أن أسمع منه هل تنبأ أم لا؟ فأجابني بجواب مغالط لي، وهو أن قال: هذا شيء كان في الحداثة أوجبته الصورة. فاستحييت أن استقصي عليه وأمسكت.
وبقيت هذه الوصمة لاصقة بأبي الطيب ما يدام يلقب بالمتنبي لقباً لازمه واشتهر به، وكان هو ينكرها على الدوام إذا أثارها خصومه وشنعوا عليه بها، وكان من هؤلاء الإمام النحوي ابن خالويه، الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني، المتوفى بحلب سنة 370، والذي استوطن حلب وكانت له مكانة رفيعة عند بني حمدان، وعرَّض ابن خالويه يوماً بأبي الطيب في مجلس سيف الدولة فقال: لولا أن الآخر جاهل لما رضي أن يُدعى بالمتنبي، لأن متنبي معناه كاذب، ومن رضي أن يدعى بالكذب فهو جاهل. فقال له أبو الطيب: أنا لست أرضى أن أدعى بهذا، وإنما يدعوني به من يريد الغض مني، ولست أقدر على الامتناع.
على أن أبا الفتح عثمان بن جني يروي عنه غير هذا فيقول: سمعت أبا الطيب يقول: إنما لقبت بالمتنبي لقولي:
أنا تِرب الندى ورب القوافي ... وسِمام العدا وغيظ الحسود
أنا في أمة تداركها الله غريبٌ كصالح في ثمود
ما مٌقامي بأرض نخلة إلا ... كمقام المسيح بين اليهود
وبرز أبو الطيب بعد هذه المرحلة شاعراً مفلقاً غزير الشعر واسع المعاني، فاق أهل عصره من الشعراء، وقد ذكر لنا أول قصيدة قالها وأثيب عليها جائزة يرضاها، قال أبو الطيب: أول يوم وصلت بالشعر إلى ما أردته أني كنت بدمشق فمدحت أحد بني طُغج بقصيدتي التي أولها:
أيا لائمي إن كنت وقت اللوّائم ... علمت بما بي بين تلك المعالم
فأثابني الممدوح بمئة دينار، ثم ابيضت أيامي بعدها.
واتصل المتنبي بعد هذا بأبي العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان، فأعجب به إعجاباً شديداً ونفق عليه نفاقاً تاماً، فأجرى ذكره عند أمير حلب سيف الدولة الحمداني، علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي، المتوفى سنة 356 عن 53 عاماً، فأمره بإحضاره عنده في سنة 337، فمدحه وحظي عنده، وشارك معه في حرب الروم البيزنطيين، وكان معه في معركة انهزم فيها سيف الدولة هزيمة منكرة تدعى بغزوة الفناء فناء أغلب الجيش الذي كان معه.
ومما يدل على عظم قدر أبي الطيب في الشعراء في ذلك الوقت، أن ابن خالويه الذي اختاره سيف الدولة لتعليم أولاده، قد قرر عليهم حفظ قصائد من شعر المتنبي، ولم يكن من العادة في ذلك الوقت أن يحفّظ الناشئة قصائد الشعراء المعاصرين.
على أن العلاقة بين أبي الطيب وبين ابن خالويه لم تخل من التنافس والمزاحمة، وكان لسيف الدولة مجلس يحضره العلماء كل ليلة فيتكلمون بحضرته، فاجتمع في مجلسه يوماً المتنبي وابن خالويه وعالم لغوي جليل يكنى كذلك بأبي الطيب، وهو عبد الواحد بن علي، الذي استشهد سنة 351 عند دخول البيزنطيين إلى حلب، فجرت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيب اللغوي، والمتنبي ساكت، فقال له الأمير سيف الدولة: ألا تتكلم يا أبا الطيب؟ فتكلم فيها بما قوّى حجة أبي الطيب اللغوي، وأضعف قول ابن خالويه، فاغتاظ منه ابن خالويه وخطَّأه، فقال له المتنبي: اسكت ويحك فإنك عجمي، وأصلك خوزي، وصنعتك الحياكة، فما لك وللعربية؟! فوثب ابن خالويه على المتنبي فضرب وجهه بمفتاح حديد لبيته كان معه، فشجه، وخرج المتنبي غاضباً ودمه يسيل على ثيابه، ثم غادر حلب إلى مصر، وذلك في سنة 346.
وفي مصر مدح المتنبي أميرها كافوراً الإخشيدي، وطلب منه أن يوليه، فلم يولِّه كافور، ويقال إن كافوراً وعده بولاية بعض أعماله، فلما رأى تعاليه في شعره وسموه بنفسه خافه فأعرض عن تعيينه، وعوتب فيه فقال: يا قوم، من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أما يدعي المملكة مع كافور؟! فحسبُكم. وبعد إقامة 4 سنوات في مصر ما عاد أبو الطيب يطيق الانتظار فانصرف كارهاً غاضباً في آخر سنة 350 وهجا كافور هجاءه المقذع المرير، وأرسل كافور وراءه من يلحق به ويعيده فلم يلحقوا به.
ويذكر لنا المؤرخون أن مكانة أبي الطيب في اللغة والنحو تجلت كذلك في مصر حين قُرئ عليه فيها في سنة 347 كتاب المقصور والممدود لابن ولاد النحوي، أبي العباس أحمد بن محمد بن الوليد، المصري، المتوفى سنة 332، فأبدى عليه ملاحظاته وخطّأه في مواضع عديدة.
وقد ذكرنا أبا الفتح ابن جني، عثمان بن جني، المولود بالموصل نحو 327 والمتوفى ببغداد سنة 392، وإمام الأدب والنحو واللغة، والذي كان راوية المتنبي وشارح شعره وناقده الذي يرتاح إليه، وقرأ ابن جني ديوان أبي الطيب المتنبي عليه وشرحه شرحاً مفصلاً في كتاب ضخم، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. قال ابن جني: قرأت عليه قوله في كافور القصيدة التي أولها:
أغالبُ فيك الشوقَ، والشوقُ أغلب ... وأعجبُ من ذا الهجر، والوصل أعجبُ
حتى بلغت إلى قوله:
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة ... ولا أشتكي فيها ولا أتعتب
وبي ما يذود الشعر عني أقله ... ولكن قلبي يا ابنة القوم قُلُب
فقلت له: يعزُّ عليَّ، كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة؟ فقال: حذَّرناه وأنذَّرناه فما نفع، ألستُ القائل فيه:
أخا الجود، أعطِ الناسَ ما أنتَ مالكٌ ... ولا تُعطِينَّ الناس ما أنا قائلُ
فهو الذي أعطاني كافوراً بسوء تدبيره وقلة تمييزه.
وكان المتنبي يرى نفسه فوق كل الناس من الأمراء والسوقة، وكان يتزيا بزي الأمراء، فيضع في وسطه سيفاً ومنطقة، وإذا ركب ويركب بحاجبين من مماليكه وهما كذلك بالسيوف والمناطق، ومن كبرياء أبي الطيب أنه، وعلى غير عادة الشعراء، لا يمدح إلا أميراً أو كبيراً من أهل الدولة، وكان من كبار تجار بغداد في عصره الحسن بن حامد وكان تاجراً أديباً متمولاً، ولما قدم المتنبي بغداد نزل ضيفاً عليه وقام الحسن بأموره، فقال له المتنبي شاكراً ومعتذراً: لو كنت مادحا تاجرا مدحتك.
على أن المتنبي كان شاعراً يروم المال ويسترفد العطاء، لا يخفي ذلك في شعره، ولا يُعرَّض به في أبياته، بل يقولها دون تردد أو مواربة، ويتضح ذلك في قصائده التي قالها في مصر والمعروفة بالكافوريات، ومنها:
قالوا: هجرتَ إليه الغيثَ؟ قلت لهم: ... إلى غيوث يديه و الشآبيب
إلى الذي تهب الدولات راحتُه ... ولا يمُنُّ على آثار موهوب
ومنها في قصيدة أخرى:
أبا المسك هل في الكأس فضل أناله ... فإني أغني منذ حين وتشرب
وهبتَ على مقدار كفيَّ زماننا ... ونفسي على مقدار كفيك تطلبُ
إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية ... فجودك يكسوني وشغلك يسلب
ولم يكن أبو الطيب في خصاله الشخصية بعيداً عن ذلك، فقد كان بخيلاً يحب المال حباً جماً، وتورد كتب التراجم عدداً من القصص في ذلك، منها ما حكاه أبو الفرج الببغاء، قال: كان أبو الطيب يأنس بي، ويشكو من سيف الدولة، ويأمنني على غيبته له، وكانت الحال بيني وبينه عامرة دون باقي الشعراء، وكان سيف الدولة يغتاظ من تعاظمه، ويجفو عليه إذا كلمه، والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات، ويتغاضى في بعضها، وأذكر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بَدْرَة فشقها بسكين الدُواة، فمد أبو عبد الله ابن خالويه طيلسانه فحثا فيه سيف الدولة صالحاً، ومددتُ ذيل دُرَّاعتي فحثا لي جانباً، والمتنبي حاضر، وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل فعلنا، فما فعل، فغاظه ذلك، فنثرها كلها على الغلمان، فلما رأى المتنبي أنها قد فاتته زاحم الغلمان يلتقط معهم، فغمزهم عليه سيف الدولة، فداسوه وركبوه، وصارت عمامته في رقبته، فاستحى ومضت به ليلة عظيمة، وانصرف، فخاطب أبو عبد الله بن خالويه سيف الدولة في ذلك، فقال: يتعاظم تلك العظمة، وينزل إلى مثل هذه المنزلة لولا حماقته!
وبعد أن ترك المتنبي مصر اتجه إلى بلاد فارس، وكانت تشهد نهضة أدبية لا مثيل لها، برعاية حكامها من آل بويه ووزرائهم، فمر بأرجان ومدح فيها الوزير ابن العميد، علي بن محمد، المتوفى سنة 366 عن 29 عاماً، وكانت له معه
مساجلات، قيل إنّه وصل إليه منه ثلاثون ألف دينار، ورحل إلى شيراز فمدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي، وكان عضد الدولة عالماً بالنحو واللغة والأدب والشعر، استقطب العلماء والأدباء، فوصل أبا الطيب بثلاثين ألف دينار.
وتبين فضل أبي الطيب في هذه المرحلة حين سأله العالم اللغوي الجليل أبو علي الفارسي: كم لنا من الجموع على وزن فِعلى؟ فقال أبو الطيب لوقته: حِجلى وظِربي. قال أبو علي: فطالع كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثاً فلم أجد، وحجلا جمع حَجَل، وهو طائر معروف، وظربى جمع ظِربان وهي دويبة منتنة الريح.
واستأذن أبو الطيب الملك عضد الدولة على أن يمضي إلى الكوفة فيحمل عياله ويعود، فأذن له، ولما فارق أرض فارس حسب أن السلامة تستمر به واستمرارها في مملكة عضد الدولة، ولم يقبل ما أشير به عليه من الاحتياط باستصحاب الخفراء، فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من أصحابه، ومع المتنبي جماعة أيضا، واقتتل الفريقان، فقُتل أبو الطيب وابنه مُحَسَّد وغلامه مفلح، بالنعمانية بالقرب من دير العاقول في الجانب الغربي من سواد بغداد.
كان لمقتل المتنبي وقع الصاعقة على أهل الأدب وجماعة الشعر، فطفقوا يتساءلون كيف قُتِل مالئ الدنيا وشاغل الناس؟ فجاءهم الجواب أن لسانه وكبرياءه سعيا في قتله وأورده رداه، قال الشاعران الخالديان محمد وسعيد ابنا هاشم بن وعكة: كتبنا إلى أبي نصر محمد الجبلي نسأله عما صدر لأبي الطيب المتنبي بعد مفارقته عضد الدولة، وكيف قُتل؟ وأبو نصر هذا من وجوه الناس في تلك الناحية، وله فضل، وأدب جزل، وحرمة وجاه، فأجابنا عن كتابنا جوابا طويلاً يقول في أثنائه: وأما ما سألتما عنه من خبر مقتل أبي الطيب المتنبي فأنا أسوقه لكما، وأشرحه شرحاً بيناً: اعلما أنه قتل بضيعة تقرب من دير العاقول، والذي تولى قتله وقتل ابنه وغلامه، رجلٌ من بني أسد يقال له فاتك بن أبي جهل بن فراس ابن بداد، وكان من قوله لما قتله وهو متعفر: قبحاً لهذه اللحية يا سبَّاب. وسبب ذلك أن فاتكا هذا خال ضبة بن يزيد العيني الذي هجاه أبو الطيب بقوله:
ما أنصفَ القومُ ضبَّة ... وأمَّه الطرطُبَّةْ
وما يشق على الكلب أن يكون ابن كلبة
فيقال إن فاتكا داخلته الحمية لما سمع ذكر أخته بالقبح في هذا الشعر، وما للمتنبي أسخف من هذا الشعر، ولا أوهى كلاماً، فكان مع سخافته و ركاكته سبب قتله، وقتل ابنه وغلمانه وذهاب ماله.
وأما شرح الخبر فإن فاتكا صديق لي، وهو كما سُمِّيَ فاتك لسفكه الدماء، وإقدامه على الأهوال في مواقف القتال، فلما سمع الشعر الذي هُجِىَ به ضبة اشتد غضبه، ورجع على ضبة باللوم، وقال له: كان يجب ألا تجعل لشاعر عليك سبيلاً. وأضمر غير ما أظهر، واتصل به انصراف المتنبي من بلاد فارس، وتوجهه إلى العراق، وعلم أن اجتيازه بجبل دير العاقول، فلم يكن ينزل عن فرسه، ومعه جماعة من بني عمه رأيهم في المتنبي مثل رأيه؛ من طلبة واستعلام خبره من كل صادر ووارد، وكان فاتك خائفاً أن يفوته، وكان كثيراً ما ينزل عندي، فقلت له يوماً وقد جاءني وهو يسائل قوماً مجتازين عن المتنبي: قد أكثرت المسألة عن هذا الرجل، فأي شيء تريد منه إذا لقيته؟ فقال: ما أريد إلا الجميل، وعذْلَه على هجاء ضبة. فقلت له: هذا لا يليق بأخلاقك. فضحك ثم قال: يا أبا نصر والله لئن اكتحلت عيني به أو جمعتني وإياه بقعة لأسكن دمه، ولا محقن حياته، إلا أن يحال بيني وبينه! قلت له: كف - عافاك الله - عن هذا القول، وارجع إلى الله، وأزل هذا الرأي عن قلبك، فإن الرجل شهير الاسم، بعيد الصيت، ولا يحسن منك قتله على شعر قاله، وقد هجت الشعراءُ الملوكَ في الجاهلية، والخلفاء في الإسلام، فما سمعنا بشاعر قتل بهجائه، وقد قال الشاعر:
هجوتُ زهيراً ثم إني مدحتهُ ... وما زالتِ الأشرافُ تُهجى وتُمدحُ
ولم يبلغ من جرمه ما يوجب قتله. فقال: يفعل الله ما يشاء. وانصرف.
ولم يمض لهذا القول غير ثلاثة أيام حتى وافاني المتنبي، ومعه بغال موقرة بكل شيء من الذهب والطيب، والتجملات النفيسة، والكتب الثمينة والآلات، لأنه كان إذا سافر لم يخلف في منزله درهماً، ولا شيئاً يساويه، وكان أكثر إشفاقا على دفاتره، لأنه كان قد انتخبها، وأحكمها قراءة وتصحيحاً.
قال أبو نصر: فتلقيته، وأنزلته داري، وسألته عن أخباره، وعمن لقى، فعرَّفني من ذلك ما سررت به له، وأقبل يصف ابن العميد وفضله وأدبه وعلمه، وكرم عضد الدولة ورغبته في الأدب، وميله إلى أهله، فلما أمسينا قلت له: يا أبا الطيب، على أي شيء أنت مجمع؟ قال: على أن أتخذ الليل مركباً، فإن السير فيه يخف على. قلت: هذا هو الصواب. رجاء أن يخفيه الليل، ولا يصبح إلا وقد قطع بلداً بعيداً، وقلت له: والرأي أن يكون معك من رجالة هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواضع المخفية جماعة يمشون بين يديك إلى بغداد.
فقطب وجهه وقال: لم قلت هذا القول؟ فقلت: لتستأنس بهم. فقال: أما والـجُراز في عنقي فما بي حاجة إلى مؤنس غيره! قلتُ: الأمر كما تقول، والرأي في الذي أشرت به عليك. فقال: تلويحك ينبي عن تعريض، وتعريضك ينبي عن تصريح، فعرِّفني الأمر، وبيِّن لي الخطب؟ قلت: إن هذا الجاهل فاتكا الأسدي كان عندي منذ ثلاثة أيام، وهو غير راض عنك، لأنك هجوت ابن أخته ضبة، وقد تكلم بأشياء توجب الاحتراز والتيقظ، ومعه أيضاً نحو العشرين من بني عمه، قولهم مثل قوله. فقال غلام أبي الطيب وكان عاقلا: الصواب ما رآه أبو نصر، خذ معك عشرين رجلا يسيرون بين يديك إلى بغداد. فاغتاظ أبو الطيب من غلامه غيظاً شديداً، وشتمه شتما قبيحاً، وقال: والله لا أرضي أن يتحدث الناس أني سرت في خَفارة أحد غير سيفي. قال أبو نصر: فقلت: يا هذا أنا أوجه قوماً من قِبَلي في حاجة يسيرون بمسيرك وهم في خفارتك. فقال: والله لا فعلت شيئاً من هذا. ثم قال: يا أبا نصر: أبخرء الطير تخشيني؟ ومن عبيد العصا تخاف على؟ والله لو أن مِـخْصَرتي هذه ملقاة على شاطئ الفرات وبنو أسد معطشون بخمس وقد نظروا إلى الماء كبطون الحيات ما جسر لهم خف ولا ظِلف أن يرده. معاذ الله أن أشغل فكري بهم لحظة عين. فقلت له: قل إن شاء الله. فقال: هي كلمة مقولة لا تدفع مقضياً ولا تستجلب آتيا! ثم ركب، فكان آخر العهد به، فلما صح عندي خبر قتله وجهت من دفنه ودفن ابنه وغلمانه، وذهبت دماؤهم هدراً.
ورثاه أبو القاسم مظفّر بن علي الزوزني بقوله:
لا رعى الله سِربَ هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل ذاك اللسان
ما رأى الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزّمان
كان من نفسه الكبيرة في جيش وفي كبرياءِ ذي سلطان
هو في شعره نبيٌ، ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني
وسار شعر أبي الطيب المتنبي في الدنيا حفظاً وشرحاً ونقداً ما لم يكن للشاعر قبله ولا بعده، واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه، وله أكثر من أربعين شرحاً ما بين مطولات ومختصرات، ولم يحصل هذا بديوان غيره، قال أبو علي ابن شهاب العكبري، الحسن بن شهاب، المولود سنة 335 والمتوفى سنة 428، وكان فاضلاً أديباً يتكسب بالوراقة: كنت أشتري كاغداً بخمسة دراهم فأكتب فيه ديوان المتنبي في ثلاث ليال وبيعه بمئتي درهم وأقله بمائة وخمسين درهما.
وانتشر شعر المتنبي بين العامة والخاصة، ولهذا سببٌ ذكره القاضي الفاضل رحمه الله تعالى ورواه ضياء الدين ابن الأثير، قال: سافرت إلى مصر ورأيت الناس يشغلون بشعر المتنبي، فسألت القاضي الفاضل فقال: إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس. ومن أشعار أبي الطيب المتنبي التي سارت في كل مكان وجرت على كل لسان:
وما الدهر إلا من رواة قصائدي ... إذا قلتُ شعراً أصبح الدهر منشدا
وإذا أتتك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني فاضل
وإذا كانت النفوس كباراً ... تعبت في مرادها الأجسام
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ... وإن أنت أكرمت اللئيم تمرَّدا
والظُّلم من شيم النُّفوس فإن تجد ... ذا عفَّةٍ فلعلَّةٍ لا يظلم
لا تشتري العبد إلا والعصا معه ... إن العبيد لأنجاسٌ مناكيد
وإذا ما خلا الجبان بأرض ... طلب الطعن وحده والنزالا
لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يُفقِرُ والإقدام قتّال
آلة العيش صحةٌ وشباب ... فإذا وليّا عن المرء ولّى