الشاعر والأديب أحمد فضل شبلول فى حوار مع «الوفد»:
أرفض التطبيع الثقافى مع الصهاينة

التوريث وترهل نظام «مبارك».. سبب ثورة يناير
بدأت مسيرة الشاعر والروائى أحمد فضل شبلول منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضى، وتنوعت اهتماماته الأدبية بين مجالات عدة أبرزها الشعر والرواية والمقال الصحفى، نال جائزتين من جوائز الدولة، أولاهما جائزة التفوق عن مجمل أعماله، ثم جائزة الدولة التشجيعية فى مجال شعر الطفل الذى نال حظًا كبيرًا من قصائده ودواوينه بديوان «أشجار الشارع أخواتى».
حصل «شبلول» عمل بعد تخرجه فى مجال السياحة والفنادق حتى أحيل إلى المعاش عام 2013، كما عمل فى مجال الصحافة الورقية والإلكترونية باحثًا ومحررا، وعمل فى النشر العلمى والمطابع بجامعة الملك سعود، وأشرف على قناة «البابطين» الثقافية الفضائية بالكويت، كما رأس العديد من المجلات.
انتخب «شبلول» عضوًا فى مجلس إدارة هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية، واتحاد كتاب مصر لمدة تسع سنوات، كما شارك فى تأسيس اتحاد كتاب الانترنت العرب عام 2005، وكان نائبًا لرئيسه لمدة أربع سنوات، كما كتب الشعر فى المرحلة الثانوية، وانتظم بنادى الشعر بقصر الحرية سنوات عدة، وأصدر دواوين كثيرة.
شارك فى العديد من المؤتمرات والملتقيات الأدبية والثقافية فى مصر وخارجها، حتى كرمته جهات ثقافية عديدة فى مصر والخارج، له العديد من الكتب فى مجال الدراسات الأدبية والنقدية وفى مجال المعجمية العربية، حتى بلغ مجموع إصداراته أكثر من 45 مؤلفًا. وله فى مجال السرد كتب مطبوعة منها «الحياة فى الرواية» وعلى شواطئ الاثنين فى القصة والرواية، والمرأة ساردة.
وتعد روايات «رئيس التحرير.. أهواء السيرة الذاتية» و«الماء العاشق» و«اللون العاشق» من أعماله الأدبية المتميزة.
حصل الأديب الكبير على الكثير من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير منها الجائزة الأولى من المجلس الأعلى للثقافة، درع التكريم من مؤتمر أدباء مصر، كما كرم فى أبوظبى والشارقة وسلطنة عمان، وترجمت بعض مقالاته وقصائده إلى أكثر من عشر لغات.
لا أؤيد هجرة الشعراء إلى عالم الرواية

«الوفد» التقت الأديب والشاعر الكبير أحمد فضل شبلول فى منزله بمدينة الإسكندرية وهذا نص الحوار،،،
< بداية.. ما العوامل التى شكلت وعيك الأدبى عندما قررت الخوض فى عالم الشعر؟ وما تأثير البيئة السكندرية عليك فى كتاباتك؟
<< القراءة والاستماع إلى المذياع منذ الصغر، هما اللذان شكلا وعيى الأدبى، فمنذ الصغر وأنا أحب القراءة؛ قراءة الكتب والمجلات (ميكى وسمير والسندباد) وكنت أشترى الكتب القديمة بخمسة قروش من بائعى الكتب على العربات الخشبية فى ميدان محطة مصر بالإسكندرية، وأقوم بإعادتها إلى للبائع – إذا أردت – وآخذ منه أربعة قروش. يعنى اقرأ الكتاب بقرش واحد. هكذا قرأت كتب مصطفى محمود وأنيس منصور وتوفيق الحكيم وروايات نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس ويوسف السباعى وغيرهم. وكنت أحب الاستماع إلى الأغانى فى المذياع وحلقات ألف ليلة وليلة والأوبريتات الإذاعية وحفلات أم كلثوم التى كانت تذاع فى الخميس الأول من كل شهر.
كما كنت أتردد يوميا – وخاصة أثناء عطلات نصف السنة والعطلات الصيفية – على مكتبة البلدية فى شارع منشا بمحرم بك والقريبة من بيتنا، كما كنت أتردد على متحف الفنون الجميلة الملاصق لمكتبة البلدية لأشاهد اللوحات والمعارض الفنية هناك.
كل هذا أسهم فى تشكيل وعيى الأدبى والتشكيلى، فبدأت أقلد ما أسمعه من شعر وأغانٍ، وأكتب الكلام المسجوع أو المقفَّى مع اضطراب فى الوزن، وأعرض ما أكتبه على مدرس اللغة العربية فى المرحلة الإعدادية ثم المرحلة الثانوية، إلى أن وجهنى مدرس اللغة العربية فى مدرسة العباسية الثانوية إلى قصر ثقافة الحرية، لأجد عالما أدبيا وثقافيا مختلفا تماما، انخرطت فيه والتقيت شعراء الإسكندرية الذين كانوا يتجمعون فى هذا القصر، وتعلمت علم العروض (أوزان الشعر) على يد الشاعر والناقد محجوب موسى، إلى أن تمكنت منه وبدأت أكتب على أوزان الخليل ثم كتبت القصائد التفعيلية وبدأت أنشر قصائدى فى المجلات المصرية والعربية، ثم أصدرتُ الديوان الأول بعنوان «مسافر إلى الله» عام 1980.
ومنذ قصائدى الأولى وأنا أحاول الكتابة عن الإسكندرية وعن عالمها المائى وتاريخها العظيم وثقافتها الثرية وأتفاعل مع البيئة المحيطة بى، ففى القصائد الأولى كانت هناك «صوفية الإسكندرية» و«إلى فتاة اسمها الإسكندرية» و«البحر والبنايات الشاهقة».. إلخ. وقد لاحظ الدارسون والنقاد أننى أكثر من مفردات البيئة والطبيعة السكندرية من مياه وكورنيش وشواطئ ورمال ومحار وقواقع وأسماك ولآلئ وطيور ونوارس.. الخ بل انعكس هذا الأمر على عناوين كتبى فكانت: ويضيع البحر، شمس أخرى بحر آخر، الإسكندرية المهاجرة، الماء لنا والورود، الماء العاشق، وكل أحداث رواياتى السبع تدور فى الإسكندرية وأحيائها وخاصة شرق الإسكندرية مثل سيدى بشر وميامى وبئر مسعود والمنتزة.. الخ. حتى شخصيات الروايات معظمهم سكندريون من أمثال الفنان التشكيلى محمود سعيد، وفى «الليلة الأخيرة فى حياة نجيب محفوظ» كان للإسكندرية نصيب كبير فيها. إذن الإسكندرية تستولى على معظم كتاباتى حتى الكتابات التى كتبتها أثناء عملى خارج مصر كلها تفيض بالحنين والذكريات السكندرية الجميلة والحميمية. ومن حسن حظى أننى قضيت فترة تجنيدى بالقوات المسلحة ما بين المعمورة ورأس التين وسيدى بشر بجوار البحر أيضاً. وكأنه القدر يرسم لى طريقى الدائم إلى جوار الشطآن والبحار فى الإسكندرية التى أطلقت عليها فى إحدى قصائدى «مليكة البحار».
الفن لا يغير الواقع.. والشعر أصبح فن النخبة
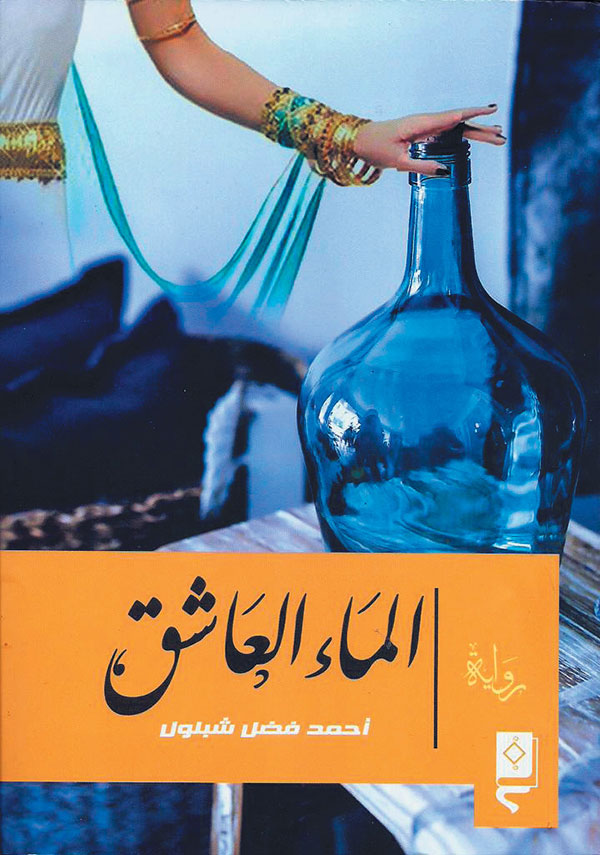
< لكل شاعر فلسفته فى حياته.. فالشاعر أحمد شوقى كان يراها «عقيدة وجهاد» والمعرّى كان يراها «تعب كلها»، فماذا عن فلسفتك فى الحياة؟
<< فلسفتى هى «العمل والإخلاص والباقى على الله»، وعدم الالتفات إلى صغار النفوس ومن يحاول وضع العقبات والعراقيل فى طريق الكتابة والإبداع والنشر.
< على الرغم من أن زوبعة الشعر الحر وقصيدة النثر قد هدأت، فإن الكثير لا يزال يعتقد أنهما قد شوَّها مشهد الشعر العربى، وربما أسهما فى انحسار مساحة القراء. هل تعتقد ذلك؟
<< لا أحد يستطيع أن يقف أمام التطور الطبيعى للأشياء، فهو من سنن الحياة، وأعتقد أن شعر التفعيلة جاء تطورًا للقصيدة البيتية، وقد خرج من رحمها وينتمى إلى موسيقاها وتفعيلاتها الخليلية، ولكن على نظام غير عددى. وهناك روائع كتبت فى هذا الشكل التفعيلى، ولكن الذاكرة العربية لا تزال تحتفظ بالجرس الموسيقى للشعر البيتى، ومعظم القراء يعتقدون أن الشعر هو الذى يُنشد ويُقرأ ويُكتب فى إطاره العمودى أو البيتى. ولكن عن طريق التراكم والأعمال الجيدة بدأ أغلبهم يقتنعون بالقصيدة التفعيلية وعالمها وجمالياتها. ثم سرعان ما جاءت قصيدة النثر، فلم يستوعبها هؤلاء القراء والمتذوقون الذين بدأوا يقتنعون بقصيدة التفعيلة بعد لأى، فحدثت الفجوة التى نراها الآن بين القصيدة الجديدة والمتذوقين الذى هجر معظمهم الشعر إلى أشكال أدبية أخرى يتفاعلون معها، وأصبح فن الشعر فن النخبة وليس فن العامة كما كان فى عصر البعث والنهضة. بل أن معظم دور النشر الآن لا ترحب بنشر الدواوين الشعرية، لأنه لا يوجد إقبال عليها.
< فى رأيك.. ما سر هذا الإقبال على قصيدة النثر من قبل شعرائنا العرب، هل هو حاجة أو غاية للرد على استنفاد الشعر الكلاسيكى وظيفته؟
<< هناك فئتان من هؤلاء الشعراء: فئة تمتلك أدواتها الشعرية امتلاكا جيدا، وكتبت القصيدة البيتية والقصيدة التفعيلية، ثم رأت أن هناك رؤى وجماليات لا تستطيع البيتية والتفعيلة التعبير عنها، فجربوا فى قصيدة النثر ونجحوا فى هذا. والفئة الثانية: هى التى لجأت لكتابة قصيدة النثر هروبًا من عدم إجادة الكتابة فى الشكلين البيتى والتفعيلى حيث يتطلب الأمر الكتابة على نسق لا يجيدون الكتابة عليه. ومن ثم رأوا أن الكتابة أسهل بكثير فلا قيود ولا موسيقى واضحة، ومعظم من يكتبون فى هذا الشكل أرى أنهم يكتبون خواطر أدبية، يسمونها قصيدة نثر، ومن لا يسميها «قصيدة نثر» يطلق عليها مسمى «نصوص» حتى يهرب من التصنيف الأدبى، وعند المواجهة يقول: والله أنا أكتب مجرد نصوص. وهو ما يذكرنى بكتاب «النصوص» الذى كان مقررًا علينا فى المدارس.
ولكن علينا أن ننظر أيضاً فى المحتوى، وربما يكون هذا أهم من الوقوف على عتبة الشكل، فما المضامين التى يريد أصحاب هذا الشكل إيصالها للقارئ؟ هناك ممن يكتبون قصيدة النثر أصحاب فكر وقضية وما يكتبونه ليس مجرد تهويمات وفذلكة لغوية وصور لا علاقة ببعضها البعض، فلا نستطيع أن نمسك نصا له ملامح وله فكرة وله جماليات ما. وهؤلاء من أصحاب المشروعات الأدبية الذين يقدمون فكرًا ورؤية يستطيع القارئ أو المتلقى الولوج إليها والتشارك معها، وللأسف هؤلاء الشعراء قلة من بين الآلاف الذى يكتبون فى هذا الشكل على مستوى الوطن العربى.
هناك من يكتبون قصيدة النثر بدافع «الفذلكة»

< هل ثمة خصوصية للشعر العربى أم أن الهوية الإنسانية للشعر أذابت الحدود أو بالأحرى أن الشعر قادر على إذابة الفوارق الجغرافية والإثنية؟
<< كان للشعر العربى قديما خصوصية، تختلف عن خصوصية الشعر اليونانى على سبيل المثال. فقد ارتبط الشعر العربى القديم بالأرض التى نبت فيها هذا الشعر، لذا نرى ذكرا كثيرا للأماكن العربية، وللعادات والتقاليد العربية، وللخيمة والخباء والصحراء والنار والحصان والمها والجِمال أو الإبل والحداء.. الخ، ولكن مع الفتوحات العربية والإسلامية والانتقال إلى حضارات أخرى فى دمشق وبغداد والتعامل مع جنسيات أخرى غير عربية، مثل الفارسية والهندية بدأت تلك الخصوصية تتبدَّل ونرى انفتاحا وذوبانا أكثر للحدود اللغوية والجغرافية، فنرى المعجم العربى يتبدل، والخصوصية تتغير، وفى العصر الراهن نرى أن التجربة أو الهوية الإنسانية هى السائدة، وأصبحت قصائد صلاح عبدالصبور وحجازى وأمل وأبوسنة وسويلم ودرويش والسياب ونازك أكثر التصاقا بالتجربة الإنسانية العامة، فالعالم كله الآن منفتح على بعضه البعض. ولم تعد هناك دولة أو منطقة معزولة عن العالم، إلا فى أضيق الحدود. وبالتالى التجارب الإنسانية أصبحت متقاربة، والتعبير عنها صار أكثر شمولا للمشاعر والأحاسيس الإنسانية، ألا تعبر قصيدة الهايكو اليابانى عن مشاعر إنسانية عامة، رغم خصوصية التجربة اليابانية، ألا تتحدث قصيدة مثل «مرثية لاعب سيرك» لحجازى عن تجربة إنسانية عامة رغم خصوصيتها الشديدة لحياة ومشاعر لاعب السيرك، سواء كان لاعبا مصريا أو أمريكيا أو روسيا أو فرنسيا.. الخ.
< هل من الممكن أن يصبح الشعر سلاحًا لتغيير واقع الإنسان، وما رأيك فيمن يقولون إن الشعر أصيب بحالة من الانحسار فى الثقافة حاليا؟
<< لا أدرى هل الشعر يستطيع تغيير الواقع أم لا؟ وهل من وظائفه أن يغير الواقع؟ الشعر تعبير جمالى موسيقى عن مشاعر الإنسان وأحلامه وآماله ومخاوفه وأحزانه، لكن أعتقد أنه لا يملك التغيير، مثلما يملكه القرار السياسى، الشعر يملك قوة روحية غير قوة القرار السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى، الفن عموما لا يغير الواقع ولكن القرارات هى التى تغير الواقع، ولكن قد يستطيع الفن التنبيه إلى شيء ما، أو إلى خلل ما، مثل فيلم يتناول ظاهرة أولاد الشوارع، أو انتشار المخدرات، أو زواج القُصّر، ولكن الذى يملك اتخاذ القرار فى هذه الحالة هى السلطة السياسية أو الاجتماعية، كأن تحتوى أولاد الشوارع، أو تعالج ظاهر انتشار المخدرات.. الخ.
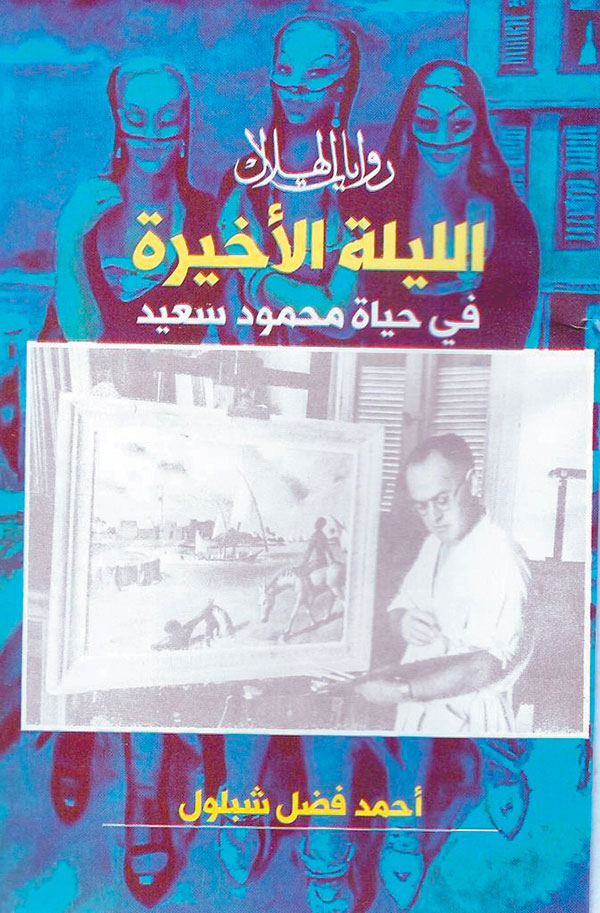
ولكن من ناحية أخرى الشعر أو الفن عموما يستطيع تعبئة المشاعر مثلما حدث فى حرب 73 فسمعنا الأشعار والأغانى الحماسية التى كانت تهز المشاعر والوجدان مثل: على الربابة باغنى، ورايحين فى ايدنا سلاح، وقبلها كانت هناك خلى السلاح صاحى، وعدَّى النهار وغيرها.
أما عن أن الشعر أصيب بحالة من الانحسار فى الثقافة، فقد يكون مرجعه إلى اختلاف وظيفة الشعر عما كان عليه قديمًا، فقد كان الشاعر بمثابة الإعلامى الذى يتحدث عن قومه ويمجد قبيلته ويتغنى ببطولتها أو يعبر عن أحزانها، ثم جاء من ينافس الشاعر هذا الدور وأصبحت هناك وزارات ورجال أعلام متخصصون، وسلبوا الشاعر هذا الدور، فلم تعد القبيلة أو الحى الذى ولد فيه الشاعر يشعر به أو يلجأ إليه، فهناك من يؤدى الدور الإعلامى طبقا لمواصفات ومتطلبات العصر. وأصبح الشعر فنا جماليا مثله مثل الرسم والموسيقى.
< كيف ترى مستقبل الثقافة العربية فى ظل الهيمنة الغربية على دول الشرق الأوسط؟
<< الثقافة العربية الآن مرتبطة بالتكنولوجيا، وكل منتجاتها غربية، ولم تعد الثقافة هى الثقافة التى فى عصر طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم. الآن الوسيلة التكنولوجية هى المتحكمة فى المسارات الثقافية، وفى كيفية تقديم الجرعات الثقافية للمواطنين والجماهير. بل ظهرت فى الآونة الأخيرة تمظهرات جديدة تتمثل فى عالم الذكاء الاصطناعى وبدأت آثاره ومساوئه تتبدى للعيان. ونحن – العرب– إذا لم نتمكن من التعامل بذكاء مع هذه التمظهرات الجديدة، فسوف يبتلعنا طوفان التكنولوجيا الذى لن يستطيع أحد إيقافه أو السيطرة عليه، وتصبح ثقافتنا العربية فى خبر كان.
< لماذا اتجهت إلى كتابة الرواية؟ وهل تؤيد هجرة الشعراء إلى عالم الرواية، ولماذا؟
<< لم يكن فى مخططى كتابة الرواية، على الرغم من أننى قرأت مئات الروايات خلال مسيرتى الأدبية، وكتبت عن بعضها دراسات أدبية، ولى أكثر من كتاب عن الرواية، قبل أن أكتب الرواية، مثل «الحياة فى الرواية» 2011، والمرأة ساردة 2007، وآفاق وأعماق (عشرون رواية مصرية) 2017، ومحيط وخليج (عشرون رواية عربية) 2018، وغيرها.
أخشى أن يبتلعنا طوفان التكنولوجيا
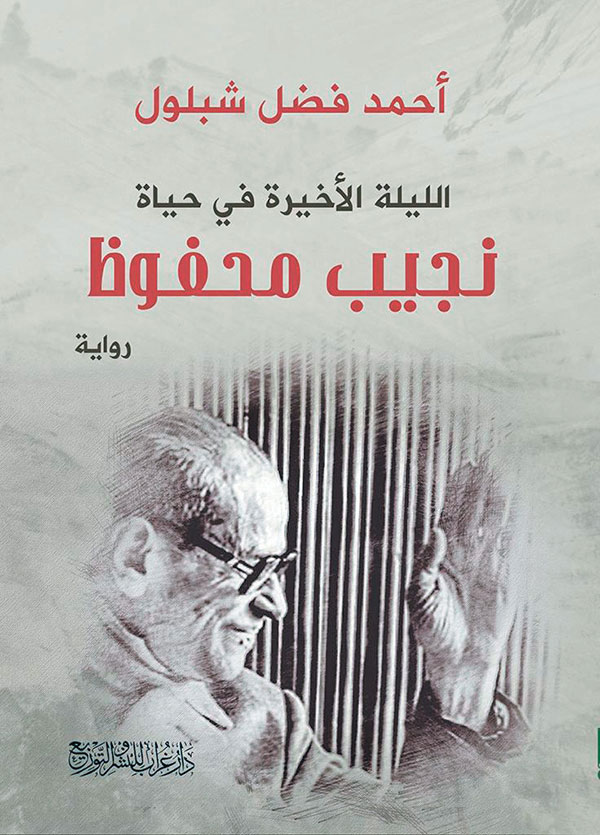
إذن أنا لست غريبًا على عالم الرواية، وعندما تعرضت لتجربة إنسانية قاسية فى حياتى أثناء عملى الصحفى خارج مصر، وددت أن أعبر عنها بطريقة أدبية، فلم أجد غير الرواية تستطيع أن تستوعب ما أود طرحه، فكانت روايتى الأولى «رئيس التحرير – أهواء السيرة الذاتية» التى طبعت ثلاث طبعات داخل مصر وخارجها. إذن التجربة هى التى فرضت نفسها علىّ وهى التى اختارت الشكل الذى أعبر به عنها، وقد لاقت تلك الرواية استقبالا جيدا داخل مصر وخارجها، وكتب عنها الكثير من الدراسات النقدية والأدبية، وصدر عنها كتاب بعنوان «سيرة الرواية ورواية السيرة» من إعداد الناقد المغربى د. مصطفى شميعة يحتوى على 20 دراسة ومقالا عنها. كما نوقشت فى رسائل جامعية خارج مصر. كل هذا شجعنى وحرّضنى على المضى فى طريق الرواية دون إغفال الشعر، فالشعر كان البوابة الكبرى التى من خلالها ولجتُ إلى عالم الرواية. وكانت الرواية الثانية بعنوان «الماء العاشق» عن الإسكندرية.. وهكذا حتى صدرت الرواية السابعة «ثعلب ثعلب» التى تعد الجزء الثانى للماء العاشق.
وبطبيعة الحال لا أؤيد هجرة الشعراء إلى عالم الرواية، إلا إذا وجد الشاعر تجربة ملحة ومسيطرة عليه وعلى وجدانه وجمّاع فكره لا يستطيع أن يقدمها إلا فى قالب روائى، لكن أن يسير الشاعر وراء الموضة الأدبية فيكتب رواية لمسايرة الواقع الأدبى فحسب، دون أن يكون مؤهلاً لذلك فهو ما لا أرضاه. وأستطيع أن أقول إن كل شاعر جيد ليس بالضرورة أن يكون روائيا جيدا، وهناك من يجمع بين الاثنين، والعبرة فى النهاية بجودة العمل الروائى سواء جاءنى من شاعر أو من قاص أو حتى من لاعب كرة.
< هل تؤيد التطبيع الثقافى مع إسرائيل خاصة أن بعض أساطين الثقافة يؤيدون ذلك؟
<< أنا من الملتزمين بتوصيات مؤتمر أدباء مصر الذى ينعقد كل عام فى محافظة من المحافظات المصرية، وأول توصية فى توصيات هذا المؤتمر؛ عدم التطبيع مع العدو الإسرائيلى. كما أننى من الملتزمين بقرارات اتحاد كتاب مصر بعدم التطبيع مع هذا العدو. وليس لى علاقة بهؤلاء الأساطين الذين يؤيدون التطبيع الثقافى. ومع ذلك فأنا اقرأ أحياناً ما يكتبه الأدباء الإسرائيليون لأعرف فيما يفكرون وماذا يكتبون، فالصراع العربى الإسرائيلى لن ينتهى قريبًا، لذا علينا أن نعرف المزيد عنهم، حتى نأمن شرهم، وتجاهلهم ليس فى مصلحتنا. وبالتأكيد هم أيضاً يقرأوننا ويترجموننا – شئنا ذلك أم أبينا– ويعرفون ماذا نكتب وفيما نفكر. لكننى أرفض فكرة التطبيع الثقافى والزيارات المتبادلة والجسور الممتدة، فما زالت هناك دماء لم تجف على أرض سيناء وفى معظم البيوت المصرية جراء حربى 67 و73، ولا أعنى بذلك التقليل من شأن شعارات التسامح والصفح والنسيان والغفران. لأن الطرف الآخر لن يتسامح ولن يصفح ولن ينسى ولن يغفر، ويعيش على مبدأ التوسع فى الاستيطان والاستيلاء على أراضى الغير بالقوة. فكيف لى بعد ذلك أن أتسامح وأغفر وأصفح وأنسى.
< عايشت انتفاضة الشعب المصرى فى 18 و19 يناير 1977، كما شهدت أحداث ثورة 25 يناير 2011، فما الفارق بينهما؟
<< نعم.. عايشت انتفاضة 18 و19 يناير 1977 بل شاركتُ فيها عندما كنت طالبًا فى كلية التجارة جامعة الإسكندرية وكتبتُ عن تلك التجربة فى رواية «رئيس التحرير»، وكتبتُ أيضاً عن ثورة 25 يناير فى الرواية نفسها، وتشاء الأحدث أن تبدأ الرواية بـ18 و19 يناير، وتنتهى بثورة 25 يناير، غير أننى لم أكن موجودًا فى مصر أثناء اندلاع ثورة يناير، والفارق كبير بين الحدثين؛ فلم تكن انتفاضة 18 و19 يناير سوى احتجاج أو اعتراض على زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، بدليل أن الشعارات التى كانت مرفوعة فى تلك الانتفاضة كانت تدور حول ذلك، وأتذكر منها (سيد بيه يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه) وسيد بيه المقصود به سيد مرعى رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت. بل هناك فصل خاص فى رواية «رئيس التحرير» بعنوان «18 و19 يناير».
إذن تلك الانتفاضة كانت بسبب غلاء الأسعار، وسرعان ما هدأت الأمور بعد أن أعلنت الحكومة تراجعها عن زيادة الأسعار، فعاد الهدوء للشارع المصرى. ثم عرضت مسرحية «مدرسة المشاغبين» فى المساء، ونسى الناس المظاهرات والانتفاضة والثورة الشعبية.
أما فى 25 يناير 2011 فالموقف مختلف تماما، فقد اجتمعت عوامل كثيرة خرجت الجماهير بسببها إلى ميادين الثورة، منها ترهل النظام الحاكم، والترويج لفكرة التوريث، والفساد الذى كان «للركب» على حد تعبير أحد أعمدة هذا النظام، وغياب العدالة فى كثير من القضايا، لذا سنجد أن شعارات 25 يناير تختلف تماما عن شعارات 18 و19 يناير، وسنجد أن الجيش كان يساند الشعب فى ثورته، مثلما ساند الشعب الجيش فى ثورة 1952.
< ما مدى ارتباطك الوجدانى بأديب نوبل نجيب محفوظ، وماذا عن افتقادك وحنينك إليه فى أعماله؟
<< حقيقة نفتقد جميعًا كاتبنا الكبير نجيب محفوظ الذى رحل فى 30 أغسطس من عام 2006، وأعتقد أنه لو كان بيننا الآن لكتب عن التحولات الكبيرة التى تمر بها مصر، ويمر بها العالم فى السنوات العشر الأخيرة. وهى تختلف عن التحولات التى واكبها فى حياته. وقد التقيته مرتين فى الإسكندرية، مرة فى كافتيريا الشانزيليزيه مع توفيق الحكيم وثروت أباظة وبعض حرافيش الإسكندرية، والمرة الثانية عند مطعم محمد أحمد فى محطة الرمل، وفى المرتين كنت أشعر أن هناك رسالة يريد أن يحمِّلَنى بها من خلال نظراته الثاقبة لى أثناء لقائنا، وأخيرا فسَّرتُ هذه الرسالة فكتبت رواية «الليلة الأخيرة فى حياة نجيب محفوظ» التى تُرجمت مؤخرا إلى الإنجليزية.
< بعض النقاد عابوا على نجيب محفوظ استخدام الفصحى على لسان أبطال رواياته حتى لو كانوا من الحرافيش فما ردك على هذا الطرح؟
<< لقد شغل هذا الموضوع بال نجيب محفوظ أثناء كتابته للثلاثية، وقال: «كنت فى صراع مع اللغة، كيف أذلِّل اللغة، كيف أطوعها، كيف يكون الحوار مقبولاً مع أنه فصيح، وكان علىّ الجمع بين اللغة الفنية واللغة الواقعية على لسان الشخصيات». وقد التزم نجيب محفوظ الفصحى لأنه وجدها لغة الكتابة.
وينبه محفوظ إلى أن هذه المشكلة لم تتبلور إلا فى وقت حديث نسبيا، وكثيرون يعتبرونها مشكلة من الدرجة الأولى، وقد تكون كذلك فى المسرح أو السينما، أما فى الرواية والأقصوصة، فالأمر أبسط من ذلك بكثير. الزمن وحده سيفصل فيها. والواقع أنى أشعر أن الاستهانة بلغة توحد بين مجموعة من البشر هو فى الوقت ذاته، استهانة بالفن نفسه، وبالعلاقة البشرية المقدسة.
وعلى ذلك فأنا مع استخدام الفصحى المبسطة والدالة فى الحوار، أما لو تحول العمل إلى فيلم أو مسلسل فالأمر يختلف، وسوف تدخل عناصر جديدة فى العمل تعبر عنه وتتحكم فى إيقاعه.
< أخيرا.. ماذا عن مشروعك «الليلة الأخيرة فى حياة محمود سعيد» هل نرى قريبًا تحويلها إلى فيلم سينمائى؟
<< الرواية تحولت بالفعل إلى سيناريو وحوار لفيلم روائى قصير أعده الشاعر د. فوزى خضر تحت عنوان «الرسَّام»، وفاز هذا السيناريو بمنحة كويتية فى ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط العام الماضى 2022، وجارى حاليا تنفيذه ليعرض – كفيلم روائى قصير– فى مهرجان الإسكندرية السينمائى فى أكتوبر القادم بمشيئة الله. وهناك مفاجأة أخرى أننى انتهيت مؤخرا من إعداد سيناريو وحوار لمسلسل تليفزيونى عن الشاعر أبى العلاء المعرى، ويشاركنى فى كتابته الشاعر د. فوزى خضر، وهو الآن فى طور الانتهاء، ثم البحث عن منتج له.

