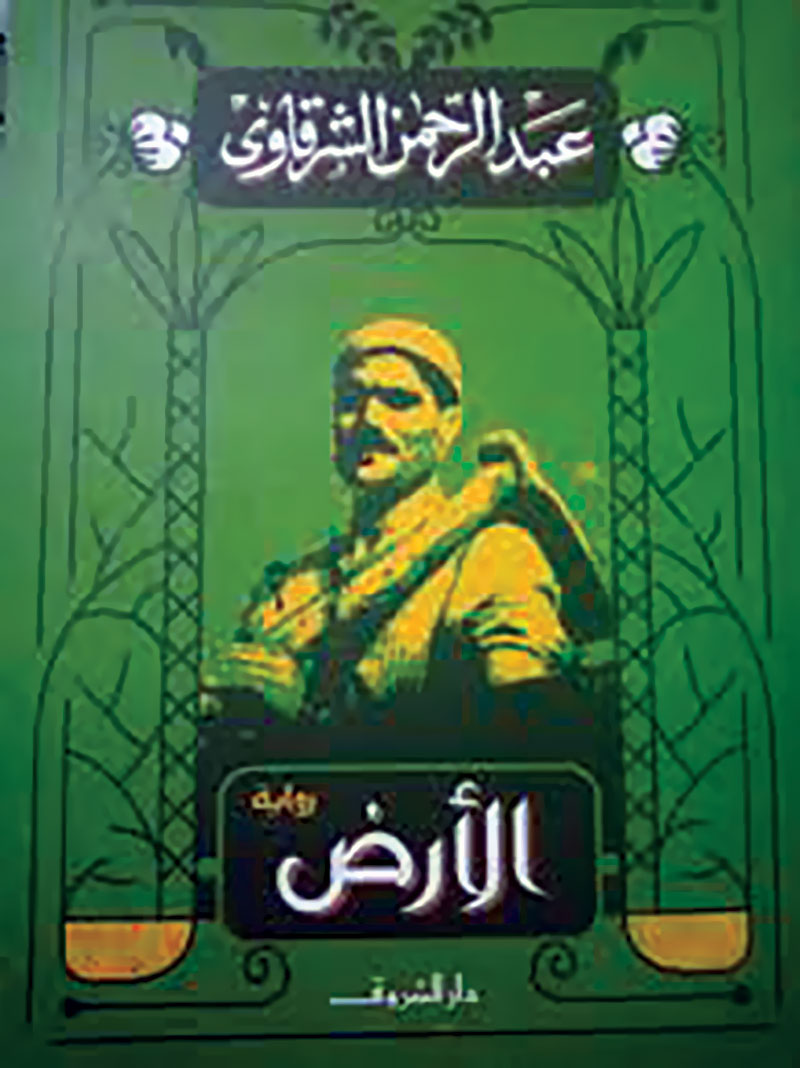أصبح رمزًا للوطنية والهوية
الفلاح فى الأدب والسرديات المصرية

تأثير ثورة ١٩ على وعى الفلاح وتحوله لمؤثر وصانع للتاريخ
انعكاس العلاقة بين المثقفين والنظام الناصرى على الرواية
بين الانعزال والوعى.. الفلاح فى الرواية المصرية قبل ثورة يوليو وبعدها
كان للأدب قصب السبق فى تغيير تلك الصورة الكلاسيكية للفلاح المصرى، التى اقتصرت على كونه راعيا للأرض، منتجا للزروع، يرزح فى عالمه الأثيرى، بعيدا عما يحدث فى مجتمع المدينة من تطور وتشابكات الفرد مع السلطة أو الاحتلال.
هكذا جاء الأدب بشقيه شعرا ونثرا، ليزيح غبارا متعمدا عن صورة الفلاح، المتمرد المقاوم للظلم والرافض للاستغلال.
ولأننا هذه الأيام نحتفل بعيد الفلاح، والذى يحل فى التاسع من سبتمبر فى كل عام، حيث يرتبط بقانون الإصلاح الزراعى الذى أقرته ثورة يوليو 52، بعد قرابة عام من بداية الثورة، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وضم الأراضى من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، نستعرض معا فى ذلك التقرير أهم الروايات التى تناولت صورة الفلاح فى الأدب المصرى على وجه الخصوص، وهل تغيرت تلك الصورة بتغير الظروف السياسية والاجتماعية للمجتمع..
وتعددت المحاور الرئيسية لتصوير الفلاح فى الأدب، فشملت:
* المعاناة والشقاء:
صور الأدب الفلاح غالبًا فى صورة المكافح الذى يتحمل مشاق العمل ليلاً ونهارًا، كما فى بعض القصص التى تصور الفلاحة وهى تحمل الطعام والرضيع فى الحقل.
* الصراع ضد الظلم:
تُبرز العديد من القصص صراع الفلاح ضد الظلم الاجتماعى والاقتصادى، سواء كان من قبل الإقطاعيين أو الاستعمار.
* الانتماء للأرض:
تؤكد القصص على حب الفلاح لأرضه وارتباطه بها كأصله ومرجعه، وعشقه للريف الذى نشأ فيه.
* الصمود والجهاد:
يظهر الفلاح فى بعض القصص بصفة المناضل البطل الذى يدافع عن وطنه وأرضه، ويشارك فى الثورات ويتحمل المسؤولية.
من أشهر الروايات والقصص التى تناولت الفلاح: رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل، «الأرض» لعبدالرحمن الشرقاوى التى جسدت نضال الفلاح المصرى ضد الاحتلال والظلم، ورواية «الفلاح» للكاتب نفسه التى تناولت الفلاح فى مجتمع ما بعد الثورة، وكذلك رواية «الحرام» ليوسف إدريس، وهناك أيضًا قصص قديمة مثل «الفلاح الفصيح» من العصور الفرعونية التى أبرزت بلاغة الفلاح فى الدفاع عن حقوقه.
** (الفلاح الفصيح).. قصة من الأدب المصرى القديم:
تعود قصة «الفلاح الفصيح» إلى العصر الأهناسى «الإقطاعى» لعام 2000 ق.م، والتى تعود ترجمتها الأصلية للنص الهيروغليفى إلى «ساكن الحقل»، ولكن اصطلح الآثاريون ودارسو التاريخ القديم على تسميتها بـ»الفلاح الفصيح».
يسرد الدكتور سليم حسن، فى كتابه الأدب المصرى القديم، أن القصة تقع فى ثلاثة أجزاء، الأول هو سرد لحكاية الفلاح وصراعه مع الموظف الفاسد الذى اغتصب ممتلكاته، ليضطر الفلاح إلى رفع 9 شكاوى إلى المدير الكبير، الذى يرفعها بدوره إلى الملك «نبكاو رع»، والذى أعجب بالأسلوب الأدبى الراقى لتلك الشكاوى، فأمر منذ أن تليت عليه الشكوى الأولى، ألا يجاب الفلاح إلى مطالبه حتى يستمر فى صياغة الشكاوى البليغة مكتوبة حتى يدخل السرور إلى قلب الفرعون، أما الجزء الثانى فهو سرد للشكاوى التى عرضها الفلاح، والتى اعتمد فيها الفلاح أسلوب التورية والاستعارة المكنية فى مخاطبة المسئول الكبير، فمرة يصفه بالميزان ومرة بالفيضان ومرة بحارس العدالة، وفى كل مرة يطالبه بإقامة العدل والانتصاف من الظالم لصالح المظلوم، وفى الجزء الأخير من القصة، ردت للفلاح بضائعه المسلوبة وعوض أيضا من مال الموظف الفاسد.
6 مكاييل من القمح.
وفى كتاب (الرواية والخيال الريفى فى مصر بين 1880 و1985)، للدكتورة سماح سليم، أستاذ الأدب العربى الحديث بجامعة روترجز، تبدو صورة الفلاح والريف المصرى منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى قبيل نهاية القرن العشرين، وتحولات تلك الصورة عبر الزمن فى النصوص السردية المصرية البارزة، وارتباطها بسياسات الوطنية وتجلياتها فى اﻷدب، إذ يظهر الفلاح خلالها باعتباره رمزًا واضحًا للهوية الوطنية.
* الفلاح فى كتابات النديم وصنوع
ويظهر الكتاب صورة الفلاح فى كتابات عبدالله النديم ويعقوب صنُّوع، حيث تبدو شخصية الفلاح ثانوية، بائسة أحيانًا، وجاهلة ومستغلة فى أحيان أخرى. شخصية حادة ومتمردة، لكنها أيضًا ماهرة فى الغش، غوغائية وساخرة فى كلتا الحالتين. لقد انطلقت تلك الكتابات من الوعى الحاد المنتشر شعبيًّا فى مصر خلال العصور الوسطى وبواكير العصر الحديث، حين كان استغلال الفلاح على يد الحكام وجباة الضرائب سائدًا، ومن خلال ذلك الوعى ابتكر النديم وصنُّوع شخصية الفلاح وثيقة الصلة بمشروع اﻻصلاح اﻻجتماعى والسياسى للحركة الوطنية فى نهايات القرن التاسع عشر، وتجسَّد ذلك سياسيًّا فى الحزب الوطنى المبكر، وفى حركة العرابيين، وجاءت اﻷعمال النثرية، فعلى سبيل المثال طوَّر يعقوب صنُّوع شخصية «ابن اﻷرض» المقهور والمتمرد الواقع تحت رحمة الموظفين العثمانيين وتحت رحمة نظام كولونيالى لا أخلاق له. بينما طوَّر النديم شخصية فلاح أكثر غموضًا جسَّدت التخلف المخجل والجهل الخاصين بالشخصية الوطنية المصرية، ومارست شخصيات صنُّوع والنديم نضالاً وطنيًّا موجهًا للبرجوازية المتأوربة الفاسدة التى ازدرت ثقافته المعترضة على الروابط والأخلاقيات التى تربطه ببلده.
** رواية «زينب»
الرواية التى يصنفها النقاد كأول رواية مصرية، وهى من تأليف الروائى الراحل محمد حسين هيكل، تدور أحداث الرواية حول مجموعة من الريفيين يعيشون تحت ظل الاستعمار، ويعانون من ويلاته، ويصور الأديب حياة البؤس التى يعيشها أهل الريف، ويصور الفتاة الريفية التى تقبل عرض الزفاف الذى يرغمها والدها عليه، على الرغم من حبها لشخص آخر، تدور أحداث الرواية حول مجموعة من الأشخاص، أهمهم «زينب» وهى فتاة ريفية بسيطة، تحب ابن قريتها «إبراهيم» ولكن يقوم والدها بتزويجها إلى «حسن» وهو أعز اصدقاء حبيبها «إبراهيم».
وتمثل شخصية «حامد» الصدام بين عالم قديم من القيم اﻻجتماعية البالية وعالم جديد طوباوى، حيث الهوية المضطربة الممزقة بين ثنائيات الهويات العتيقة والحديثة: «الشرق/ الغرب، الجنس/ الحب، الغنى/الفقر، الواقع/ الخيال». هذه الصورة المتمزقة لحامد انعكست على سلوكه اﻻنعزالى من آن ﻵخر فى غرفته بعيدًا جدًا عن الحياة الجماعية لحقول العزبة، وهى الصورة التى حكاها هيكل عن نفسه فى أثناء شروعه فى كتابة الرواية، وهو فى باريس يكتب على ضوء مصباح. ويصور هيكل حالته «ﻷعزل نفسى عن باريس وأرى، فى عزلتى، الحياة فى مصر محفورة فى ذاكرتى وخيالى»، وهو ما تعقب عليه الكاتبة «استعارة متكررة لعلاقة الذات الجديدة بنقضيها الجدلى (اﻵنى) -العالم خارج النافذة- اﻵخر»، هذا اﻵخر فى رواية زينب هو الجمع المحتشد الشبيه برموز اﻻختزال، وهو المجتمع الريفى السلفى، المادة الخام للخيال الوطنى، اﻻغتراب الاجتماعى الذى يعانى منه حامد تجعله يقضى أيامه متأملاً بلا نهاية فى الحقول.
** يوميات نائب فى اﻷرياف
بينما يمثل الذات السردية فى يوميات نائب فى اﻷرياف، وكيل نيابة ساخر كُلف بالعمل فى إحدى قرى مصر، يقضى أيامه فى جرائم مثيرة للشفقة، ارتكبها محليون، وينتقل بين عدد لا نهائى من الدوسيهات القانونية، فيما تمضى أمسياته الوحيدة مع رفيقه الوحيد وملجأه، الصحيفة. ويبدو بغض وكيل النيابة للفلاحين، والجهل المستشرى حيث القانون الفرنسى المستورد، هو وحده السلطة الرمزية البريئة فى نظر الحكيم «لا أحد برىء فى قرية الحكيم عدا القانون ذاته، الذى يمثل بنقائه وبعدم تمييزه كليًّا الشرعية اﻷخلاقية لحداثة عالمية تأخذ شكل اﻷمة باعتبارها صنفًا مثاليًّا. أن أيًا من الشخصيات فى الرواية - باستنثاء وكيل النيابة المستفز- لا يستطيع أن يصل إلى روح القانون»، أما عن الطبيعة فى قرية الحكيم، فهى تعكس العفن والقذارة والفلاحين متآمرين بطبيعتهم العدوانية، حتى يصل وصفهم من قبل وكيل النيابة بشكل جماعى بأنهم «ذباب» و»ديدان ورائحتهم مثل رائحة القردة فى حديقة الحيوانات»، تلك الحالة التى كان عليها وكيل النيابة جعلته يصرخ فى وجه مُحضر شرطة بقوله «إن تلك اﻻجراءات التى تتبع فى أعمالنا القضائية طبقًا للقوانين الحديثة ينبغى أن يُراعى فى تطبيقها عقلية هؤلاء الناس ومدى إدراكهم وقدراتهم الذهنية، أو فلنرفع تلك المدارك إلى مستوى تلك القوانين»!
* انعكاس العلاقة بين المثقفين والنظام الناصرى على الرواية
وإذا انتقلنا إلى صورة الفلاح فى روايات مرحلة 1952، وما بعدها، تتبدى لنا تلك العلاقة الإشكالية بين نظام 52 والمثقفين، إذ رحب معظم الكتاب التقدميين بثورة 1952، التى فتحت مجالاً لضرب ثقافة يسارية نشطة بجذورها الممتدة للإصلاح الزراعى الذى تبناه النظام، وانعكس على النشاط الثقافى الرسمى، فأسست وزارة الثقافة فى عام 1958 مركزًا للفنون الشعبية، ومعهدًا ومكتبة للدراسات الشعبية، فما بين عامى 1952 و1970 صدر ما لا يقل عن اثنتين وعشرين رواية عن الريف، تحول بعضها إلى أعمال مصورة كبيرة، ولأول مرة، يصبح الفلاح فى مركز التاريخ المصرى، ليس باعتباره ضحية أو باعتباره رمزًا محددًا ومرتكزًا عليه لماض غابر وإنما باعتباره موضوعًا حيًّا وممثلاً لتغيير تاريخى، وعليه كانت ثورة يوليو تنظر إلى المثقف باعتباره «ملتزمًا» بمبادىء النظام، إذ نُظر إلى الكتابة باعتبارها فعلاً سياسيًّا تداخل مع مجموعة متكاملة من العلاقات اﻻجتماعية والأيديولوجية المتنازع عليها، وقد انعكست هذه النظرة على الإنتاج الروائى وبدا ذلك فى نظرة عبدالرحمن الشرقاوى ويوسف إدريس إلى الفلاح كشخصية سردية متمردة، فى حين كان ينظر كتاب آخرون أمثال محمد عبدالحليم عبدالله ويوسف السباعى وثروت أباظة إلى رسم صورة الفلاح باعتباره كمحافظ سياسيًّا وسرديًّا، واضعين الصراعات اﻻجتماعية والسياسية المركزية للقرية فى إطار من الحبكة المفرطة فى العاطفية، وعلى ذلك كان هؤلاء الكتاب مدللين لدى النظام ومتصدرين للمناصب المهمة فى المشهد الثقافى، وبذلك مثلت رواية رد قلبى ليوسف السباعى التى صدرت عام 1955 مثالًا جيدًا للعلاقة بين القص واﻷيديولوجيا، فالصعود الطبقى للفلاحين مرتبط باﻻرتقاء مهنيًّا وأيديولوجيًّا مع اﻹدارة العسكرية الوطنية الجديدة آنذاك.
** صورة الفلاح فى «الأرض» وتأثره بثورة ١٩:
تتناول رواية «الأرض» لعبدالرحمن الشرقاوى، الريف المصرى فى منتصف القرن الماضى بكل تفاصيله، علاقاته مع المدينة، معيشته، علاقة أهل الريف مع بعضهم البعض، موقفهم من حكومتهم التى كان يتزعمها حزب الشعب آنذاك، ارتباطهم بماضيهم المتجسد بمشاركتهم بثورة 1919 ومحاولة إحيائه عبر تأييدهم لحزب الوفد، كما يصف تعلقهم بأرضهم كون وجودها يعنى استمرار وجودهم، وما يميز هذه الرواية، أن الشرقاوى قد صور القرية بأكملها وبمختلف شخصياتها بدءاً من العمدة وانتهاءً بالعاطلين عن العمل والذين لفظتهم المدينة بعيداً ليعيشوا مهمشين فى الريف فجاء الوصف شمولياً للقرية وأشخاصها.
وقد استند كتاب(الرواية والخيال الريفى فى مصر) إلى العلاقة الإشكالية بين المثقفين والدولة الناصرية فى تناوله لرواية «اﻷرض» لعبدالرحمن الشرقاوى، والتى صدرت عام 1952 فقد تلقَّت تقديرًا منذ صدورها من قبل الدوائر الثقافية التقدمية، واعتبرها محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس «مثالاً لامعًا على قص جديد بازغ فى مصر»، واكتسبت وضعًا عظيمًا باعتبارها عملًا واقعيًّا ثوريًّا واشتراكيًّا» بسبب تفكيكها الصورة الرومانتيكية للقرية والفلاح. وتبدو فى تلك الرواية أن الشخصية الجمعية للقرية هى الفاعل اﻷول الذى تحكى عبره اﻷحداث المشتركة والذكريات والتطلعات، وأن المادة الخام من اﻷساطير والحكايات هى محاولة لإعادة بناء الذات للقرية وعلاقتها بالعالم الخارجى فى حدود الملحمية واﻻإهام ومنحها القوة لذلك.
** رواية «الفلاح»
تمثل هذه الرواية زاوية أخرى لواقع الفلاح بعد الثورة الاشتراكية، حيث تصور صراع الفلاح مع من يريد استغلاله فى مجتمع ما بعد الإصلاح الزراعى. صور الأديب عبدالرحمن الشرقاوى، فى هذه الرواية، كيف أن أعداء الإشتراكية تسللوا إلى مناصب قيادية فى القرية وما زالوا يستغلون الفلاح ويحجرون على حريته ويحرمونه من حقوقه كما فعل أجدادهم، وتصور الرواية لوعة القاهرى المثقف إذ تنكشف له هذه الحقيقة.
*روايات ما بعد النكسة:
فيما مثلت الروايات التى جاءت بعد نكسة 1967، تلك الثنائية الضدية بين «الحلم/ الواقع، الماضى/الحاضر، اﻷصالة/المعاصرة، الريف/المدينة» حيث الذات المنشطرة نتيجة الفقد الناتج عن الهزيمة لتبرز التفسخ التاريخى للذات جغرافيًّا ووجوديًّا.
ويبدو ذلك فى رواية «أيام اﻹنسان السبعة» لعبدالحكيم قاسم ثم رواية «شرق النخيل» لبهاء طاهر. ومازلنا مع كتاب (الرواية والخيال الريفى فى مصر) حيث يبدو «تحوَّل قص القرية فى السبعينيات لأشكال هامشية وفردانية وغير منطقية من المعتقدات الطائفية والشعائرية من أجل استكشاف الطبيعة اﻷسطورية للثقافة الشعبية وكذلك الجانب القسرى والحدى الخفى فى المجتمع الريفى». وترى الكاتبة أن رواية «أيام اﻹنسان السبعة» تمثل التضاد بين الثقافة الريفية وخطاب النظام عن الحداثة، «اﻷيام السبعة فى عنوان الرواية هى سبع لحظات منفصلة فى حياة شاب نشأ فى قرية صغيرة من قرى الدلتا. يصف كل مرحلة فى سنة صوفية دائرية تدور حول رحلة حج سنوية لضريح السيد البدوى فى طنطا، ويحدد مرحلة بعينها من تطور هذا الطفل/الرجل حيث يكبر خارج دائرة الجماعة وينتهى به منفيًّا من سر تماسكها وزمانها السحرى التقويمى». أما رواية «شرق النخيل» لبهاء طاهر «يتيح بناء الرواية اﻷمثولى لبهاء طاهر تفكيك الثنائية المألوفة التى تميز سرد القرية - مدينة/قرية، أصالة/حداثة- من خلال تضمينها جميعًا فى مستوى جدلى وإعادة خلقها باعتبارها فضاءات متوازية للتمثيل السردى لدراما فردية وجماعية… وعلى الرغم من أن الماضى والقرية فى مركز الدلالة فى «شرق النخيل» ولكنهما ليس مترادفين ويمثلان الجنة الموعودة، ولكنهما يتصارعان حول الحقيقة والعدل وإرادة الحياة واﻻتحاد، كما هى الحال فى المدينة».
هكذا نجد أن صورة الفلاح فى الأدب المصرى قد شهدت تطورا ملحوظا، فما قبل ثورة يوليو حيث تلك الصورة الاعتيادية للفلاح المنعزل عن عالم الحضر والأحداث الكبرى لوطنه، ورضوخه للظلم والاستغلال، بينما تتحول صورته بعد ثورة يوليو ليصبح فاعلا ومشاركا فى صنع الحدث، ورمزا للهوية الوطنية المصرية.